ملاحظات المحرر: خاطب رئيس معهد بروكنجز، ستروب تالبوت، جمهوراً في جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس. وفيما يلي ملاحظاته التي أعدّها لتوصيلها للجمهور.
أتقدم بالشكر لكينت سيفرود، عميد كلية الحقوق، كما أشكر مارك رايتون، رئيس الجامعة، على التزامهم بالشراكة بين جامعة واشنطن ومعهد بروكنجز. إن هذه الشراكة تجدي نفعاً جيداً بفضل رؤيتكم وقيادتكم، وبفضل انخراط كليتكم أيضاً مع زملائي في واشنطن العاصمة. هناك ثلاثة منهم معي اليوم: ستيف بينيت، وهو ضابط التشغيل الأول لدينا، والذي فعل الكثير لبناء أساس قوي للشراكة، وبيل جالستون، والذي عمل كجزي من التعاون بين برنامج دراسات الحكم في بروكنجز ومركز دانفورث بشأن الدين والسياسات، وأخيراً جون مايكل أرنولد، الذي يعمل في مكتبنا التنفيذي.
بينما أصبح لبروكنجز وجامعة واشنطن “توجهاً عالمياً” بطرق شتى، إلا إنهما مازالا في الأساس مؤسستان أمريكيتان على نحو أصيل. فنحن مدينان بالكثير لـروبرت بروكنجز، الذي تمتع بسيرة أمريكية أصيلة. فقد ولد في الشرق، واتجه للغرب عندما كان مراهقاً، واستقر هنا في سانت لويس.
بالإضافة لنجاحه كرجل أعمال، فقد اتجه ربوبرت بروكنجز للخدمة العامة، نتيجة لكرمه وحبه للخير ولشهرته كمربي. وكأحد الجمهوريين، قام الرئيس الديمقراطي وودرو ويلسون بتعيينه للمساعدة في تحسين كفاءة الحكومة الأمريكية.
أقنعت هذه التجربة بروكنجز أنه يمكن لما يجري داخل أروقة الحكومة أن يستفيد مما يدور في الخارج من أفكار تقوم على أساس البحث العلمي المستقل.
بعد خمسة وتسعين سنة، مازال هذا هو المنطلق الفكري الذي يحمل اسمه. وهو أيضا المنطلق الفكري لكثير من العمل الذي يجري هنا في جامعة واشنطن.
فنح لا نلتف حول تاريخاً مشتركاً ومتبرعاً مشتركاً فقط، ولكننا نحمل تحدياً مشتركاًً أيضاً.
مهمتنا هي المساعدة في تحليل وحل المشكلات التي تواجه أمتنا، وهي كثيرة ومعقدة. ولكن يمكن، في اعتقادي، أن تتجمع تحت أربعة عناوين عامة:
– أولاً، نحتاج إلى استعادة كامل عافيتنا من الركود الكبير الذي حدث بين عامي 2008 و2009 بطريقة تخلق فرص عمل جديدة وتستعيد القدرة على إيفاء الديون طويلة الأمد لاقتصادنا.
– ثانياً، لابد من إعادة بناء الثقة التي تلاشت عند الكثير من الأمريكيين في أن أمريكا مازالت مكاناً للفرص الفردية لنا ولأبنائنا.
– ثالثاً، لابد أن نحافظ على بيئتنا ونعزز الرخاء عن طريق الحد من انبعاث الكربون ونطور مصادر الطاقة النظيفة.
– رابعاً، علينا ممارسة الريادة العالمية في عصر التغيير الدينامكي وفي مواجهة المخاطر الحالية، مثل الانتشار النووي والتغير المناخي.
يلوح فوق هذه التحديات المحددة التحدي العام لتقوية مؤسسة أمريكية عليا أصيلة وأساسية، وهو الشكل المميز لنا في الديمقراطية الدستورية.
سواءٌ وصلنا أم لم نصل إلى مهام إصلاح اقتصادنا، وتحسين مجتمعنا، وإنقاذ كوكبنا، وقيادة العالم، فهذا يعتمد على ما إذا كان يستطيع 300 مليون منا الاستفادة من تنوعنا مع تشكيلنا لمجتمع واحد يسعى للوصول لوحدة الهدف في نفس الوقت. وباختصار (وباللاتينية)، E pluribus unum “جميعنا معاً لنصل إلى هدف واحد”
إذاً ما هو مدى التزامنا بهذا الشعار؟ الإجابة هي: ليس بالشكل المطلوب. ففي كثير من الأحيان أصبح ما نسميه “الحوار الوطني” مباراة من الصراخ. وبدلاً من اقتراح حلولاً للمشاكل معاً، ننزلق إلى تبادل اللوم وتوجيه الشتائم. فنحن نعاني من انهيار في الحوار المهذب، وهو العنصر الأساسي في الديمقراطية السليمة.
فالبذاءة الواضحة المنتشرة في هذه الأيام هي سبب ونتيجة في آن واحد لمشكلتين أخريين مرتبطتين تزعجان كياننا السياسي: الاستقطاب المتنامي في مجتمعنا، والضعف المفرط والمتكرر في مؤسساتنا الحاكمة.
والكثيرون في هذه البلد محبطون إن لم يكونوا مشمئزون من هذا الوضع. وكذلك الكثيرون في جميع أنحاء العالم، والمجتمع العالمي متمثلاً على نحو جيد في هذه الجامعة، وأنا متأكد أنه يوجد بينكم أنتم هنا في هذا المساء من يشعر بهذا أيضاَ. فهم يرون، وأنتم ترون، ونحن كأمريكيون يجب أن نرى الفترة القادمة باعتبارها تشكل اختباراً ليس للحكومة الأمريكية فقط، وليس للديمقراطية الأمريكية، ولكنها تشكل اختباراً لفكرة الديمقراطية في حد ذاتها.
في غضون قرناً من الزمان منذ مجيء السيد بروكنجز إلى واشنطن للعمل في إدارة الرئيس ويلسون، ظلت أمريكا مثالاً لكثير من بلدان العالم في كونها نظاماً سياسياً يعمل من أجل صالح البلدان الأخرى مثلما تعمل من أجل صالحها.
إن قدرتنا على الحفاظ على قيادتنا في الخارج تعتمد على مقدرتنا في القيام بدور أفضل في حكم أنفسنا هنا في الداخل وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أن نتعامل ونتحدث مع بعضنا البعض بطريقة أكثر تحضراً
صحيح كانت هناك فترات من الحدة في الماضي، وكان بعضها أسوأ مما نعانيه اليوم. ولكن الأسوأ في كل هذا بالطبع هو ما حدث في ستينيات القرن التاسع عشر، عندما انقسمت الأمة حرفيا إلى شطرين على نحو دموي.
وخرج الرئيس السادس عشر، وأول الرؤساء الجمهوريين، في خطابه الافتتاحي ليبدأ بعبارة “مواطنو الأمة المستاءون”. واختتم كلمته بتوجيه نداء أن يعطوا فرصة لأنفسهم، وهنا أقتبس عبارته، أن “يرجعوا إلى الطبيعة الخيرة التي داخلنا”.
وقد اقترح أحد مستشاريه أن ينهي الخطاب بإشارة إلى “الملاك الحارس للأمة”. وفي إعادة كتابة هذه العبارة، قام الرئيس لنكولن بإعطاء العبارة معنى حرفي يتعلق بالأرض. فبدلاً من طلب التدخل الإلهي، جعل منها موضع مسئولية بشرية لنحافظ على مصالحنا المشتركة في عقولنا وعلى عواطفنا في داخلنا.
وبالحق فإن رئيسنا الرابع والأربعين، باراك أوباما، يدين بجنسيته، ناهيك عن إنجازاته من أعلى منصب في البلاد، إلى الرئيس السادس عشر. قبل أسبوعين، قيم الرئيس حالة الاتحاد الأمريكي في جلسة مشتركة للكونغرس مع الإصغاء لما يدور في كثير من بلدان العالم.
كان الرئيس يوجه خطابه إلى لجنة تشريعية كانت قد انقسمت بعد انتخابات خاصة للتجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ومع هذا لا تعني الحكومة المنقسمة في داخلها وعلى نفسها بالضرورة انقساماً في الأمة. في الواقع، يمكن لنظامنا القائم على حزبين أن يخدم قضية التعددية الديمقراطية عن طريق ضمان أن للناخبين حرية الاختيار من بين فلسفات عن كيف ينبغي أن نحكم أنفسنا. هذا ما كان يحدث في الماضي، وهو ما يمكن أن يحدث في المستقبل.
لكن لكي تكون الحزبية مفيدة، لابد وأن تكون متزنة بالرغبة من جانب قادتنا في الكونجرس أن يتناقشوا حتى الوصول إلى نقطة معينة ثم بعد ذلك يأتي التشريع. وأن يتنافسوا حتى نقطة معينة، ثم الوصول لحل وسط ومن ثم التعاون. ليس هذا فقط ما تحتاجه الدولة؛ فاستطلاعات الرأي تظهر ما يحتاجه الأمريكيون. فهم يحتاجون هذا الآن على نحو خاص، نظراً للصعوبات التي يواجهونها والمخاوف المتعلقة المستقبل.
ومع ذلك، ما يرونه في واشنطن، وبالتحديد في كابيتول هيل، هو ما يبدو في كثير من الأحيان معركة ضارية مستمرة بين مخيمات لا يمكن أن تتصالح. حيث يتحول ما كان ينبغي أن يكون أرضية مشتركة إلى أرض نزاع سياسي.
أحد أسباب هذه الظاهرة خلال الأربعين عاماً الماضية هو وجود ضعف أو تآكل تدريجي لأرضية الوسط الأيديولوجي في الكونجرس الأمريكي. قام بيل جالستون ودارسون آخرون في معهد بروكنجز بإنتاج بيانات قوية توضح مدى ما وصل له كابيتول هيل حيث أصبح بؤرة الاستقطاب في أمريكا.
وقد كان هذا حقيقياً منذ نصف قرن. في الستينيات من القرن الماضي، كان أكثر من 40 بالمائة من أعضاء دوائر الكونجرس معتدلون. ثم انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 10 بالمائة في السنوات اللاحقة.
اليوم، أصبحت الفجوة بين الأحزاب عميقة في مجلس الشيوخ. يوضح تحليل سجلات التصويت أن أكثر الديمقراطيين تحفظاً في هذه الدائرة هو بن نيلسون سناتور نبراسكا، الذي ينحى يساراً عن أكثر الليبراليين الجمهوريين، السناتور أوليمبيا سنوي والسناتور سوزان كولنز عن ولاين ماين.
علاوة على ذلك، تحولت المسئولية الدستورية لمجلس الشيوخ في تقديم المشورة والموافقة في كثير من الأحيان إلى عرقلة صريحة. والمثالان السيئان الأكثر شيوعا هو استخدام، أو سوء استخدام، المماطلة في تعطيل التشريعات التي تحظى بغالبية الدعم، واستخدام “سلطات الأسرار” – التصويت السلبي الواقعي – لتعطيل الموافقة الرئاسية على المعينين، الأمر الذي يحول دون تنفيذ السلطتين التنفيذية والقضائية لمهامهم الدستورية.
إن الاستقطاب والاختلالات التي تتسبب فيه على المستوى الفيدرالي انعكست في البلاد بصورة عامة. والخريطة الانتخابية للولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن خليط متزايد من الولايات الزرقاء والحمراء وتوجد المقاطعات الزرقاء والحمراء داخل تلك الولايات. بينما يتلاشي البنفسجي.
في العقود الأخيرة، قد اتجه تقسيم الدوائر التشريعية نحو جمع الليبراليين والمحافظين، وبالتالي عزلهم عن بعضهم البعض، الأمر الذي يحول الحدود بين المقاطعات إلى خطوط معركة أيديولوجية.
ثمة مشكلة أخرى وهي أن المعركة أصبحت رياضة دموية باهظة الثمن. فالحملات ليست ساحقة التكلفة على المرشحين وفقط؛ بل إن لها أيضاً تأثير رهيب على فعالية وحتى شرعية نظامنا الديمقراطي. لماذا؟ بسبب تدفق المبالغ الضخمة والمعلن عنها بشكل غير كاف إلى سلالات خزائن سياسية: السخرية من جانب المواطنين والناخبين؛ والحواجز أمام دخول منافسين محتملين؛ تضارب مصالح أصحاب المكاتب؛ الابتزازات التي يمارسها الموظفون العموميون على الشركات والأفراد الخاصة؛ وما يمكن أن يسمى “مرض احتلال المناصب”- في مجلسي الكونجرس ولكن بصفة خاصة أعضاء مجلس النواب، الذين يقعون في شراك تزاحم لا ينتهي من أجل زيادة تمويل الحملة المقبلة.
فضلاً عن التسبب في كل ذلك الضرر، فإن ضخ الأموال الخاصة في المنافسة السياسية يفاقم من الانقسام الأيدلوجي في مجتمعنا بصورة عامة. يوجد تأثيران لكميات الأموال الضخمة التي تضخها جماعات ذات مصالح خاصة في حزب أو آخر: حيث تستخدم في الانتخابات التمهيدية في مساعدة المرشحين الأكثر تطرفاً؛ وفي الانتخابات العامة تعمل على تحفيز المرشحين المعتدلين لكي تتودد إلى المتبرعين الذين يمتلكون الدعم المالي ويمكنهم إقناع الآخرين على تصديق أو قبول فكرة.
ثمة مشكلة أخرى أننا في حاجة إلى أن نكون على علم بل ويجب علينا من حين لآخر علاج: الوضع الخطير لوسائل إعلامنا الوطني.
إن الصحافة الصحية ضرورية لديمقراطية سليمة. يحتاج المواطنون – والناخبون- إلى مصادر معلومات موثوق بها وتحليل متوازن.
منذ جيل مضى، يمكنني القول بأن معظم الأمريكيين كانوا يحصلون على أخبارهم من مزيج من: ثلاث شبكات تلفزيونية وطنية؛ وثلاث مجلات إخبارية وطنية (إحداها – مجلة Time- التي عملت بها)؛ ونصف دستة تقريباً من الصحف الوطنية والدولية التابعة للدوائر الرسمية. حيث إن جميع هذه المنافذ معتدلة، أو ذات ميول سياسية غير متطرفة، في أرائها وتمتلك بصفة عامة معايير عالية من الدقة الواقعية والإنصاف.
ذلك الذي كان يحدث فيما مضي، وهذا ما يحدث الآن.
ما اسميه وسائل إعلام تقليدية هو ظل لما كانت عليه فيما مضى. إننا نعيش اليوم في عصر المدونات، والمئات من قنوات تليفزيون الكابل والمحطات الإذاعية – والتي في الغالب ما تكون ذات أصوات مرتفعة. ما اعتدنا عليه هو إذاعة قد تحولت إلى “طرح ضيق” أو حتى “طرح صغير” – استهداف الجماهير القلة المستقلين المدعمين ديموغرافياً وأيديولوجياً.
ونتيجة لذلك، فإن الحوار الوطني ذاته قد انقسم إلى عدد من الحوارات المختلفة التي كثيراً ما تبدو مثل سباقات حماسية لمعارضة أحزاب. وعندما يتحدث أناس متفقين في الرأس ويستمعون لبعضهم البعض، فهذا يؤدي إلى تقارب عقولهم ويقرون بتحيزهم.
إن بلقنة موجات البث الإذاعي والإنترنت قد أسرعت وعمقت نقل أمريكا من ساحة عامة للأفكار إلى متاهة من غرف إنتاج الصدى المتنافسة والتي تحتوي بداخلها على أخبار موثقة – مثل أين ولد رئيسنا أو هل درجة حرارة الأرض ترتفع أم لا، وما السبب في حدوث ذلك – ويتم طرحها في الغالب جانباً. يتم الإعلان عن الأخبار التافهة – كالأكاذيب- مثلاً بصورة تخدم هذا أو ذلك الهدف السياسي. وكنتيجة لذلك، فإن الكثير مما يتردد في أنحاء هذه الغرف يكون غير عقلانياً فضلاً عن كونه غير صحيح.
لذلك، فإن خلاصة القول أن أمتنا تواجه ليس فقط تحديات هائلة في مثل هذه الظروف – ونعني اقتصادنا ومجتمعنا، وبيئتنا، ومكانتنا ودورها العالمي. لكننا أيضاً نواجه تحدي في هذا الأثناء أو، كما طرحه لينكولن، في طبيعتنا.
والآن اسمحوا لي أن أنتقل إلى البحث عن حلول، وكيف يمكن لمراكز بحثية مثل بروكنجز وجامعات مثل جامعة واشنطن أن تسهم في هذا البحث.
سأبدأ بالتحديات التي نواجهها في الحقل العملي، ثم سأتحول إلى السياسة، ثم إلى كياسة المعالجة للموضوع.
على المستوى العملي، سأستشهد بعدد قليل من تلك الأمثلة الكثيرة التي وقفت عليها: يتعاون كل من مركزي بروكنجز ومركز Weidenbaum بجامعة واشنطن على الحد من إساءة استعمال سياسة التعطيل. في هذه الأثناء، كان يناقش زملائي في جامعة واشنطن مع مسؤولي الكونجرس سبل الإسراع من عملية شغل مناصب الفرع التنفيذي في الوقت الذي يتم فيه صياغة التشريع الآن على القيام بذلك فقط. في حالة إصدار ذلك الأمر، فسوف تكون خطوة صغيرة ولكنها واحدة في الاتجاه الصحيح.
لا تزال هناك خطوات كبيرة ضرورية يجب اتخاذها في مجموعة واسعة من القضايا الأخرى. سوف أذكر اثنتين فقط من جدول أعمالنا في معهد بروكنجز.
على مستوى تمويل الحملة، فيبحث مفكرونا عن طرق لاستخدام الأموال العامة الملائمة ووسائل إعلام جديدة وتكنولوجيا شبكة معلومات اجتماعية لتشجيع المتبرعين الصغار على الإسهام بمرشحين للمناصب العامة. سوف يساعد ذلك على المستوى الجزئي في موازنة النفوذ السياسي المتطرف للمساهمين بالأموال الطائلة.
على مستوى تقسيم الدوائر الانتخابية، فنحن نعمل على وضع خطة من شأنها أن تفتح أمام عامة الناس تفحص عملية التقسيم الحالية المبهمة للدوائر الانتخابية وبالتالي تستطيع المجموعات المدنية مراجعة بيانات التعداد السكاني والانتخابي التي سوف يستخدمها مشرعو الولاية عند وضع الرسم المفصل للمقاطعات. إذا لم يفعلوا مثل ما يرون، فيستطيع مواطنون معينون تقديم بدائل خاصة. قد أطلقت ولاية فيرجينيا مسابقة لرسم خرائط تقسيم للمناطق بهدف ترسيم الدوائر الانتخابية التشريعية في الكونجرس. تشارك أعداد ضخمة من طلاب الجامعات في جميع أنحاء الولاية، حيث يستخدمون برنامج مجاني وضعه فريق مشترك من معهد بروكنجز وجامعة جورج ماسون. سوف يقوم توم مان من مؤسسة بروكنجز ونورم أورنستين من معهد أمريكان إنتربرايز بالتحكيم في هذه المسابقة واختيار الخرائط الفائزة.
لا يمكنني تصديق مثل هذا التزاوج المثالي بين مبادئ الديمقراطية القائمة على المشاركة والاستخدام المبتكر لتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين. ولا يمكنني تصور مثل هذا النموذج المثالي الذي تخرج به المؤسسات البحثية من بوتقة التفكير المجرد. إن توم ونورم ليسا مجرد جزء من العملية السياسية وفقط – بل يساعدان أيضاً في إصلاحها.
دعونا الآن ننظر في القضايا السياسية، بدءاً من الاقتصاد والحاجة إلى التوفيق بين الانتعاش والنمو مع القدرة على الإيفاء بجميع الديون. لا نستطيع القيام بذلك بدون تخفيض الإنفاق وزيادة العائدات. يجد الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس صعوبة في تقبل هذه النظرية الحسابية التي لا مفر منها للاستقامة المالية. بالرغم من أن المحافظين والاقتصاديين الليبراليين يتقبلونه، وكلاهما موجودان معنا في بروكنجز كما تفعل أنت هنا في جامعة واشنطن. إنهم يطلقون إنذار موحد تقريباً حول عدم الاستقرارا المالي طويل المدى لاقتصاد أمتنا، وإنهم يضمون الصفوف خلف الحاجة لرفع العائد بالإضافة إلى خفض الإنفاق.
هذا التوافق ذو النطاق الواسع في الرأي هو بداية لإحداث تأثير من حيث المبدأ في كلا طرفي الطيف السياسي، مما سُيرجح أيضاً انضمام المحافظين والمسؤولين الليبراليين المنتخبين.
في الواقع، هذا يحدث بالفعل. وعلى صعيد الجمهوريين في مجلس الشيوخ، قد أيد توم كوبورن أوكلاهوما توصيات اللجنة الرئاسية حول العجز، بالرغم من دعوة اللجنة لزيادة عائدات الضرائب، بينما على صعيد الديمقراطيين، فقد وقع أيضاً ديك دوربين على تقرير اللجنة، بالرغم من دعوتها لخفض الإنفاق والاستحقاقات.
يعتمد نمو اقتصادنا أيضاً على مدى منافسة أمريكا في السوق العالمية. تعتمد القدرة على المنافسة في المقابل على مشروعين في قلب ما يحدث في هذا الحرم الجامعي وآخرون يحبونه: الابتكار، والذي تُغذيه البحوث الرئيسية في مختبراتك الخاصة وبالطبع التعليم نفسه.
لا تزال أمريكا رائدة التعليم العالي في العالم، ولكننا نتخلف عن كل من الدول المتقدمة والناشئة في الصف الدراسي K-12.
والخبر السار هو أنه وفي ظل هذا الجو القتالي السياسي لواشنطن، فإننا نجد دعماً واسعاً لبعض الأفكار المعنية بكيفية تعزيز هدفين: هما النمو المدفوع بالابتكار للاقتصاد بشكل عام وقطاع التصدير بشكل خاص؛ ومعايير أكثر صرامة لتعليم الجيل القادم من مواطني أمتنا.
إن التفكير في أولائك الشبان الأمريكيين يقودنا إلى الأولوية الثالثة التي ذكرتها في البداية: وهي أن نضمن لهم ولأطفالهم مستقبل مستدام للطاقة وجو أرضي ملائم للعيش. وهذا يعني العمل على إبطاء التغيرات المناخية.
إن أفضل طريقة لتحقيق ذلك من خلال إصدار قانون يفرض ضريبة على انبعاثات الكربون وبالتالي يهيئ دوافع اقتصادية للطاقة النظيفة. ولكن هذا لن يحدث في أي وقت قريب، نظراً للمأزق الذي نشب العام الماضي في الكونغرس حول خطة مقايضة الانبعاثات الغازية. لذلك قد يستطيع خبراء في مؤسسات كذوينا المساعدة في حل المأزق التشريعي الذي يشجع على دعم واسع النطاق لاقتصاد منخفض الكربون على أساس أن الطاقة النظيفة لها منافع بيئية من شأنها أن تحمل العبئ عن كثير من الديمقراطيين، وفوائد الأمن القومي التي سوف تروق للجمهوريين، والأرباح التجارية التي ستعود على القطاع الخاص.
تلك ثلاث محاور للنقاش قد يقوم الباحثون والاقتصاديون هنا في جامعة واشنطن ومعهد بروكنجز بناء بحوثهم وتحليلهم عليها. أحد هؤلاء الخبراء هو رئيس إدارة التعليم الخاص وهو كيميائي معروف قدّم خدمات جليلة أثناء شغله نائب رئيس لجنة مجلس البحث القومي المعنية بـ “مستقبل الطاقة الأمريكية” والذي ساهم إلى حد كبير في وضع تقريرها المؤثر للغاية.
أعرف من خلال التحدث معه أن مارك [رايتون] يوافق على أهمية إشراك مجتمع رجال الأعمال في عملنا على الاقتصاد بصفة عامة وعلى عملية التحول إلى اقتصاد نظيف أخضر بصفة خاصة. ومع ذلك، للشركات الأمريكية موارد هائلة للاستثمار والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الجديدة. ونحن في مؤسسة بروكنجز نُشرك رؤساء الشركات في بحوث خبرائنا بأشكال مختلفة. وأنت تقوم بنفس الشيء في جامعة واشنطن، لا سيما من خلال اتفاقك على الفحم النظيف مع عدد من الشركات والمرافق العامة.
اسمحوا لي التحول الآن من أولوياتنا الداخلية إلى السبل التي يمكن أن تقدمها الجامعات والمؤسسات الفكرية في تحسين النظام الدولي حتى يتسنى لنحو 193دولة في العالم القدرة على التقدم نحو تحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التهديدات المشتركة بشكل أفضل. مرة أخرى، يمكنني الاستشهاد بالعديد من الأمثلة، ولكنني سوف أبقى مع هذا المثال الذي أمامنا في السياق المحلي: العلاقة بين الطاقة النظيفة ومواجهة تغيرات المناخ.
بقدر ما لاقى الكونجرس الأمريكي من تردد في إصدار قانون يفرض ضريبة على انبعاثات الكربون، هكذا أيضاً، فإن الأمم المتحدة قد تحركت ببطء شديد نحو سعيها في الحصول على معاهدة عالمية ملزمة للحد من الانبعاثات. مرة أخرى نحن بحاجة لحل مؤقت؛ نحن بحاجة لوسيلة لتجاوز مشكلة الجمود السياسي والدبلوماسي.
يمكن تحقيق ذلك من خلال استغلال حقيقة أن الولايات المتحدة والصين هما المصدر الرئيسي لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ونظراً لكونهما أكثر مسؤولية عن هذه المشكلة من غيرهما، فيجب عليهما تحمل مسؤولية البحث عن ايجاد حلول.
إذا استطاعت الولايات المتحدة والصين أن تتعاون في مجال الطاقة النظيفة، فستتحفز الدول الرئيسية الأخرى المسببة للانبعاثات – أمثال الهند والاتحاد الأوروبي والبرازيل وأندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية – للانضمام في دائرة موسعة من الدول لتنسيق ممارساتها وسياساتها للحد من الانبعاثات على الصعيد العالمي.
تم توظيف الجامعات الأمريكية والمؤسسات الفكرية، بحكم خبراتها واتصالاتها، جيداً للمساعدة في تصميم استراتيجيات لهذا التعاون، وخاصة إذا كانت تربطها علاقات بالجامعات الصينية، مثل شراكة جامعة واشنطن مع جامعة فودان في شنغهاي ومؤسسة بروكنجز مع مركز Tsinghua في بكين.
اسمحوا لي في الختام أن اقترح كيف يمكن لمؤسساتنا المساعدة في رفع البلاء المتشابك للحزبية المتطرفة والاستقطاب الأيديولوجي وضعف كياسة الحوار.
إن حياتنا السياسية والمدنية اليوم ليست “متأثرة” وفقط ولكنها مضروبة- بل أقول مسممة – بفضل التغيرات المناخية المتزايدة لطبيعتنا. أجد ترياقاً هاماً لهذا السم من خلال الروح التي تشترك بها جامعة واشنطن وبروكنجز مع بعضهما البعض ومع العديد من المؤسسات الشقيقة.
شعاركم باللاتينية هو Per Veritatem Vis، ويعني “القوة من خلال الحقيقة”. ويبدأ البحث عن الحقيقة مع الاعتراف واحترام الحقائق. قال دانيال باتريك موينيهان – الذي كان متميزأً في الأكاديمية بنفس القدر الذي يتميز به في الساحة العامة، والذي خدم في الحكومة مع رؤساء جمهوريين وديمقراطيين- ذات مرة مقولة مشهورة “قد نتمتع بأرائنا الخاصة ولكن ليس لنا حقائقنا الخاصة”
النتجية الطبيعية لهذه التذكرة هو أن يكون ولا سيما للمفكرين – والسياسيون – الذي يحترمون الحقائق أرائهم الخاصة. يعلم الله أن بات موينيهان كان لديه أرائه الخاصة وقد دافع عنها بقوة وحماس. وكذلك الحال يعمل مفكرونا – ومدرسونا (وعمداؤنا) مثل كينت سيفرود على العمل الإيجابي في مجال التعليم العالي وكذلك يعمل زملاؤه، مثل بيل غالستون على استعادة الثقة في الحكومة والدعوة إلى إنشاء مصرف للبنية التحتية القومية.
لكونها ليست بجامعة (أو دولة)، فإن لمؤسسة بروكنجز شعاراً باللغة الإنجليزية. إنه يتكون من ثلاث كلمات الجودة والاستقلالية والتأثير. ومع ذلك فإن شعارنا مرادف لشعاراتكم. “الجودة” تعني الوفاء بأعلى المعايير العلمية. “الاستقلالية” وتنطبق على كل من المؤسسة وأفرادها من المفكرين – إنها ترجمتنا للحرية الأكاديمية.
فضلاً عن وجود بروكنجز داخل طريق Beltway وليس في قلب البلاد، فنحن نعتني عناية خاصة بالمحافظة على استقلالنا السياسي. فنحن نعمل مع مفكرين من الدرجة الأولي بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو خدمتهم في إدارة معينة – أو ربما ينبغي أن أقول: بالالتفات إلى المصلحة العامة، بغض النظر عن الحزب الذي يقود البيت الأبيض. وهناك عدد من زملائنا عمل في إدارة جورج دبليو بوش، وعدد قليل من زملائنا السابقين يعملون الآن في إدارة باراك أوباما. وبهذا المعنى، فنحن نعيش في واحة غير حزبية في مدينة تعاني من حزبية مفرطة.
لاحظ أنني قلت غير حزبية وليس “مدعوماً بأعضاء من حزبين”. إن التمييز مهم بالنسبة لنا. حيث يعني هذا المفهوم السابق أن حزبي، الجمهوريين والديمقراطيين، يعملان معاً. شيء جيد ونادر هذه الأيام أن تعني كلمة غير حزبي أن الحزبين فيما بينهما لا يحتكرون الأفكار الجيدة، ولا بالضرورة تعني أن تلتقي السياسة المثلي في نقطة وسط بين أولويات الحزبين. في الواقع، إن الأفكار الجيدة تنبعث من الحوار المدني الواقعي والعملي والعقلاني والذي يتضمن بشكل قاطع النقاش. ويشمل ذلك الأصوات التي لا ترتبط بأيٍ من الحزبين.
وهذا ما أسميه الأساس الفكري الفلسفي الذي ننتهجه في بروكنجز. بالرغم من الطبع الفظ للرأسماليين، فيتقبل بعض أعضاء الكونغرس هذا النهج.
على سبيل المثال لقد عملنا مع مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس النواب الذي يطلقون على أنفسهم اللجنة الحزبية Center Aisle Caucus، والتي تضم قيادتها بالمناسبة ممثلي ولاية ميسوري، جو أن إيمرسون وكارناهان روس. تعمل جامعة واشنطن على المساعدة في تنمية هذا التطور باستضافتها لأول اجتماع للجمعية الانتخابية تحت عنوان “تراجع الكياسة” في وقت لاحق هذا العام.
سوف يعقد هذا الحدث في ضوء ما يدور كل يوم في قاعات المحاضرات والفصول الدراسية وغرف الندوات والاجتماعات لدينا في بروكنجز. إن حرمك الجامعي، مثل مجمع المباني الخاص بنا قبالة منطقة Dupont Circle، هو منطقة خالية من الاستقطاب حيث كان الناس في جانبين متناقضين من النقاش حول بقاء السياسة المالية أو الخارجية في نفس هذا الإطار في ظل هذه التغيرات المناخية لطبيعتنا والتي ذكرها أبي لينكولن منذ 150 عام مضى.
في الواقع، إننا نؤدي دورنا في تجمعات من مثل هذا النوع أو ذاك لرفع جودة وكياسة حوارنا الوطني.
لكن الحوار بحكم تعريفه يجب أن يكون في اتجاهين. وهكذا أشكركم الآن على حسن استماعكم وأترك المجال لكينت – ولكم.




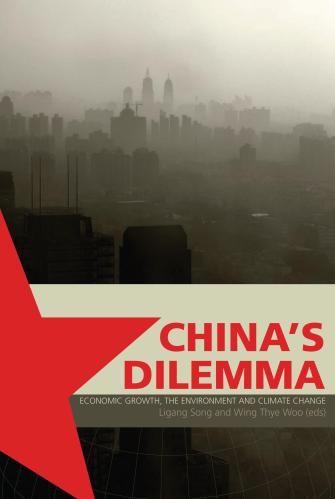
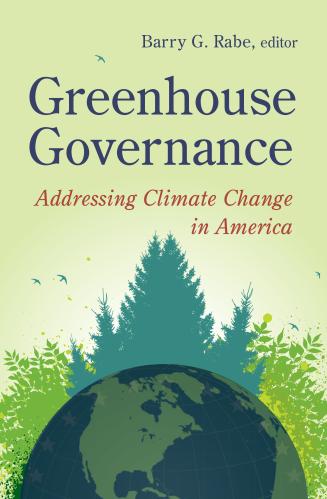



Commentary
استعادة وحدة الهدف و كياسة الخطاب في أميركا: التحدي الذي يواجه المراكز البحثية و الجامعات
February 7, 2011