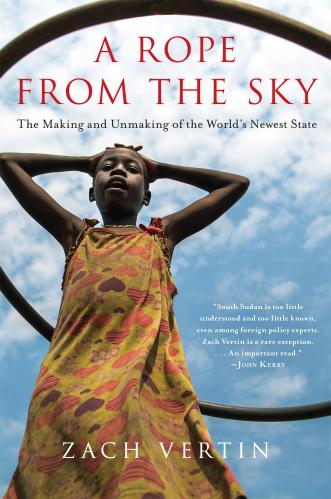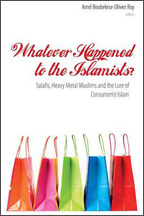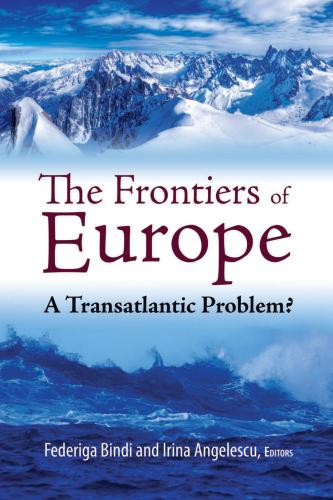برزت تركيا كلاعب مهم، لكن محيِّر، في منطقة الشرق الأوسط الكبير وما بعده. وتأرجحت سياساتها مع توسّع دورها، وباتت اليوم تؤدّي دوراً مهماً في القرن الأفريقي وفي الدول المجاورة لها. يقيّم زاك فيرتين التغيّرات في سياسة تركيا الخارجية ويفسّر كيف تتفاعل سياسات البلاد الداخلية وطموحات نظام أردوغان مع الحقائق الاستراتيجية الأوسع التي تواجهها البلاد. وعلاوة على المقابلات التي أجراها المؤلّف في القرن الأفريقي والعواصم الخليجية، تأتي المواد والاقتباسات أدناه من مشاورات المؤلّف مع مسؤولين أتراك وخبراء في السياسة الخارجية ودبلوماسيين ومعلّقين في أنقرة وإسطنبول في مارس 2019. نُشرت هذه المقالة بدايةً في مجلّة Lawfare بعد أن حرّرها دانيال بايمان، وهذه ترجمة للنسخة الأصلية.
هزّ صومالي كئيب رأسه قائلاً: “سيكون القرن الأفريقي الضحية الأولى”. لعلّه كان يتحدّث عن الإرهاب أو التغيّر المناخي أو المجاعات التي نكبت المنطقة مراراً، لكنّه كان يشير إلى عدوى سامّة جديدة مستورَدة من الشرق الأوسط، ألا وهي الأزمة الخليجية التي حرّضت منذ العام 2017 المملكةَ العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين ضدّ قطر وحليفتها تركيا. لقد أصاب هذا العداء الآن القرن الأفريقي، وهو منطقة مجاورة للخليج العربي تكافح أصلاً لمعالجة عللها القديمة والراسخة.
ويبرز اسم تركيا باستمرار في النقاشات الجديدة حول النفوذ الخارجي في المنطقة، وتبرز التخمينات بشأن دوافعها في هذه النقاشات أيضاً. وفيما تعدّ أنقرة نفسها قوّة خيّرة تدفعها سياسة خارجية “مبادِرة وإنسانية”، تقول الدول الخليجية المنافسة إنّ خطوات الرئيس رجب طيب أردوغان في القرن الأفريقي تعكس سعياً خطيراً لعملية إعادة إحياء لـ”عثمانية جديدة”.
فهل لأنقرة مخطّط كبير للمنطقة أم يتمّ التضخيم من طموحاتها؟ في محاولة الإجابة على تلك الأسئلة، ينبغي أخذ ثلاث وجهات نظر بعين الاعتبار: نظرة عن كثب إلى نشاطاتها الأخيرة في دول القرن الأفريقي وتركيز متوسّط المدى على المنافسة الإقليمية مع الدول الخليجية الخصمة وتقييم واسع الزاوية لعملية صنع السياسات الخارجية التركية في وقت تغيّرات داخلية استثنائية. معاً تساعد وجهات النظر هذه على وضع سياق للانخراط التركي في القرن الأفريقي ولرغبة تركيا في الوصول بنفوذها إلى ما يتخطّى جوارها القريب. لكنّ وجهات النظر هذه تكشف عن دولة تركية في خضمّ البحث عن هويّتها، في الداخل والخارج، وهي دولة لا يهمّها تطبيق أجندة كالأجندة العثمانية الجديدة التي يخشاها نقّاد تركيا، ولا يمكنها ذلك حتّى.
نظرة عن كثب: الانخراط التركي في القرن الأفريقي
يتحسّر دبلوماسيو أنقرة على وضعهم في صفّ “الوافدين الجدد” الخليجيين عند الحديث عن القرن الأفريقي وعن المنافسة الأوسع في منطقة البحر الأحمر. فتبعاً لهؤلاء الدبلوماسيين، ليست تركيا ناشطة في القرن الأفريقي لفترة أطول فحسب، بل كان انخراطها متنوّعاً أكثر من “دبلوماسية دفع الأموال” التي تحبّذها الدول الخليجية أيضاً. ولدى الدبلوماسيين الأتراك هؤلاء حجّة موثوقة، والصومال دليل على ذلك.
لقد زار أردوغان مقاديشو للمرّة الأولى في العام 2011 في فترة مجاعة مهلكة، فكان القائد غير الأفريقي الأوّل الذي يزور منذ عقدَين من الزمن العاصمة الصومالية التي مزّقتها الحرب (وهذه فكرة لا ينسى الدبلوماسيون الأتراك ذكرها أبداً). وما بدأ كمبادرة إنسانية بالأساس تطوّر ليصبح سياسة أشمل: فأغدقت أنقرة بأموال المساعدات وأطلقت المشاريع التنموية وفتحت المدارس وانخرطت بدور ريادي في وضع أجندة بناء الدولة، بما في ذلك افتتاح منشأة عسكرية ضخمة لتدريب الجنود الحكوميين الصوماليين. واليوم، تشغّل شركات تركية مطارات مقاديشو وموانئها وتزخر أسواقها ببضائع تركية الصنع وللخطوط الجوية التركية رحلاتٌ مباشرة إلى العاصمة، وهي الشركة الأولى التي تطيّر رحلات كهذه بين شركات الطيران المهمّة.
وقد لاقت مقاربة أنقرة في الصومال، التي يضمنها استعطاف أردوغان للتضامن الإسلامي وحضور بادٍ أكثر على الأرض مقارنة بالجهات المانحة التقليدية، ثناء كبيراً من الصوماليين. فللكثيرين، مدّة الانخراط التركي والعدد الأدنى من الشروط المقرونة بهذا الانخراط يشكّلان تناقضاً جلياً مع تصوّرات التدخلات الغربية الفاشلة في الماضي. ومؤخّراً، عيّنت تركيا مبعوثاً خاصاً للصومال في العام 2018، وهذه خطوة تجري للمرة الأولى في السياسة الخارجية التركية، وأناطته بتجديد الجهود للمصالحة بين حكومة الصومال الاتحادية وإقليم صوماليلاند الانفصالي، بغضّ النظر عن أرجحية تحقيق ذلك على المدى القريب.
وفيما يشير المسؤولون في أنقرة إلى أّنهم باتوا يثمّنون قيمة القوّة الناعمة التي تؤمّنها استثماراتهم في الصومال، لم يتمّ تصوّر حضور تركيا كمشروع استراتيجي طويل الأمد في البداية. فتحوّله التدريجي إلى دور بارز أتى نتيجة تجربة تعلّمية أكثر منه لعبة مدروسة لإبراز القوة. وهو دور رافقه نقاش داخلي حول كيفية تصوّر هذا التموضع، لا في الصومال فحسب بل في أرجاء القارّة أيضاً.
ويمثّل الانخراط التركي في الصومال النمو الأضخم لسياسة “الانفتاح على أفريقيا” الطموحة التي أطلقتها أنقرة في العام 2005 وهدفت إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي والتجاري التركي في أرجاء القارّة. وشملت المبادرة افتتاح عشرات السفارات الجديدة ورحلات للخطوط الجوية التركية ومؤتمرات قمة تركية أفريقية اعتيادية. وعلى الرغم من تحقيق تقدّم ملحوظ في السنوات الأربع عشرة التي مرّت منذ إطلاق المبادرة (42 سفارة و54 وجهة سفر الآن)، كانت الاستثمارات متواضعة نسبياً، ويقرّ الدبلوماسيون أنّ المرحلة التالية من هذه الاستراتيجية لم تُرسم بعد.
في سياق مشابه، السودان دولة أخرى ذات أكثرية مسلمة في القرن الأفريقي، ولها تاريخ من النفوذ العثماني. وقد خضعت هذه البلاد، حتّى الشهر الماضي، لحكومة إسلامية إسمياً (وقمعية بلا شك) ذات صلات تاريخية بجماعة الإخوان المسلمين. ولطالما كانت علاقة السودان بالولايات المتحدة متقلقلة، ممّا يجعلها تابعاً جذاباً لأردوغان، الذي سعى إلى جعل تركيا نموذجاً للعالم المسلم وبديلاً للعالم الغربي الذي تخلّى عن سلطته الأخلاقية.
وضاعف أردوغان جهوده في السودان في أوائل العام 2017، فاستثمر في ما أصبح، بحسب الكثير من الآراء، علاقة وطيدة مع عمر البشير، الزعيم الذي ولّد الكثير من الجدل آنذاك والذي تُوجّه المحكمة الجنائية الدولية إليه أصابع الاتهام. فخلال زيارة أردوغان الرسمية إلى السودان، زار الرئيسان جزيرة سواكن، وهي مركز تجارة عثماني تاريخي متوقفة نشاطاته منذ زمن بعيد على الساحل السوداني على البحر الأحمر ونقطة انطلاق في الماضي للمسلمين الأفريقيين في سفرهم إلى مكّة. ومن بين عشرات اتفاقيات التعاون الموقّعة تعهّدٌ من أردوغان بإعادة تأهيل هذه الجزيرة وإحياء أهمّيتها الثقافية وإطلاق رحلات عبور سنوية إلى الحرمين الشريفين.
لكنّ الاتفاقيات الثنائية، التي تبلغ قيمتها مجتمعة ما يناهز 650 مليون دولار، شملت أيضاً خططاً لزيادة التعاون العسكري وتشييد مرسى للسفن الحربية والمدنية في سواكن. فعَلا صوت الإعلامَين المصري والسعودي على الفور، واتّهم أحدهما السودان “بالتآمر على مصر تحت غطاء الجنون التركي” ووضَع زيارة أردوغان في إطار المحاولة الواضحة “لمضايقة” القاهرة. لكن لا مبرّر بالإجمال للمخاوف المصرية والخليجية من قاعدة عسكرية تركية على البحر الأحمر، فصغر سواكن وويلات تركيا المالية الراهنة تقلّل من احتمالات حصول ذلك، أقلّه على المدى القريب. لكنّ الجزيرة التاريخية تعكس علاقات معمّقة مع السودان، وهي تتحلّى بالتالي بقيمة رمزية في لعبة الشطرنج الأوسع بين الدول المتنافسة الشرق أوسطية. ولم تمرّ بلبلة الدول المنافسة مرور الكرام في أنقرة.
فقد واجهت شراكة تركيا المُجدّدة مع السودان صعوبات غير متوقّعة بعد ذلك، وهي الآن في وضع خطير للغاية بعد خلع الرئيس عمر البشير الشهر المنصرم والفوضى السياسية التي تلفّ الخرطوم. فالتظاهرات الشعبية التي انتشرت في السودان في مطلع العام 2019 تركت تركيا في حيرة حيال الموقف الذي عليها اتّخاذه، إذ عبّر مسؤولون كبار سرّاً عن قلقهم الكبير حول احتمال وقوع انهيار خارج عن السيطرة وعن تقديرهم لمطالب الشارع في الوقت عينه. وقبل بضعة أسابيع فقط من إسقاط الجيش السوداني عمرَ البشير، قال لي أحدهم إنّ الخيار المفضّل هو “عملية انتقالية مُدارة، لكن كيف لنا أن تتمّ رؤيتنا على أننا ضدّ شعب يكافح لنيل حقوقه؟”
وفي الوقت الذي يكافح فيه السودان للبقاء متماسكاً ولوضع عملية انتقالية سياسية، تحرّكت مصر والدول الخليجية المنافِسة لتركيا بسرعة، مقدّمة الموارد وفارضة نفوذها في محاولة لتشكيل سودان جديد على صورتها. في غضون ذلك، أعرب الرئيس أردوغان عن رغبة في المحافظة على “علاقات بلاده الراسخة” مع السودان ونكرت حكومته الادّعاءات بأنّ اتفاقية سواكن ألغيت. لكنّ مسؤولاً تركياً كبيراً أقرّ سرّاً أنّ تركيا في حالة “ترقّب” الآن وتميل إلى تأييد حكومة انتقالية ولكنّها مدركة للتصوّرات الشعبية حيال علاقة تركيا الوثيقة بالنظام السابق. وسيتطلّب ترتيب أمور العملية الانتقالية في السودان وقتاً. وفيما يبقى الكثير من الأمور غير محدّد، يرى الكثيرون في سقوط البشير ضربة استراتيجية للسياسة الخارجية التركية في المنطقة.
وفيما شكّل الصومال والسودان الهدفَين الأكثر طبيعية للتعاون التركي، تُعتبر أثيوبيا القوّة الصاعدة في المنطقة، ومحور الاستلطافات الأحدث للدول الخليجية. وعلى الرغم من اللجوء إلى دبلوماسية المدراس والجوامع التركية، وهما أداتان أساسيّتان في القوّة الناعمة الإسلامية التي ينتهجها أردوغان، في أثيوبيا، كانت أنقرة أقلّ بروزاً نسبياً في هذا البلد ذي الأكثرية المسيحية الأرثوذكسية. لكن تشير التقارير إلى أنّ استثماراتها التجارية في أثيوبيا تفوق تلك التي تقوم بها في الصومال والسودان معاً، ويحثّ عدد متنامٍ من الأصوات التركية أنقرة على جعل أثيوبيا أولوية.
فبالإضافة إلى تأمين سوق جديدة للتجارة، قال لي بعض المعلّقين الأتراك الصقوريين إنّهم يعتقدون أنّ شراكة مع أثيوبيا تؤمّن سطوة مفيدة ضدّ مصر، في حال بقيت العلاقات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وحلفائه متضعضعة. ونظراً إلى تغيّر السياسة الأثيوبية في الصومال في العام 2018، مع تعهّد رئيس الوزراء آبي أحمد بالعمل مع حكومة مقاديشو الاتّحادية، يرى المراقبون الأتراك أيضاً فرصاً جديدة للتعاون مع أثيوبيا في موضوع الصومال. وقد تتحقّق رغبة أولئك المطالبين بانخراط تركي أكبر، إذ يقول المسؤولون الأثيوبيون إنّ أردوغان اقترح مؤخراً أن يزور أديس أبابا.
ولإتمام الجولة في القرن الأفريقي، قامت تركيا أيضاً باستثمارات متواضعة في دولة جيبوتي المرفئية الصغيرة، وتبقى أريتريا خارج المعادلة، في الوقت الراهن. فرئيس تلك البلاد يصطفّ بشكل قاطع في المعسكر السعودي/الإماراتي لأنّ الشركاء الخليجيين دفعوا له لاستئجار قاعدة عسكرية في العام 2015 وساعدوا لاحقاً على رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على هذه البلاد المنبوذة من زمن.
ويقول المسؤولون الأتراك إنّ اهتمام بلادهم الأولي في القرن الأفريقي كان اهتماماً اقتصادياً ومتمحوراً حول كسب القيمة. وأوضحوا أنّ تقديراً للعملة الجيوسياسية الأوسع تبِع ذلك ولم يأتِ سوى نتيجة مرور الزمن والظروف الإقليمية المتغيّرة. ويقرّون أنّ خطوات تركيا اليوم في القرن الأفريقي ربما مدفوعة جزئياً بالمنافسة مع الدول الخليجية الخصمة، واصفين كلّهم هذه الخطوات بأنّها ردود فعل.
فقد قال أحدهم لي: “أجل، لقد وجدنا أنفسنا في منافسة هناك، لكنّنا لم نذهب إلى تلك المنطقة بحثاً عن ذلك”.
المدى المتوسّط: تركيا وأزمة الدول الخليجية
عندما يُسأل المسؤولون والمحلّلون الأتراك عن أولويّات السياسة الخارجية التركية، يقول معظمهم إنّ القرن الأفريقي ليس ضمن المسائل الخمسة الأولى، لكنّ أكثريةً تؤكّد أنّه مهمّ لتركيا على الرغم من ذلك. ويتطلّب فهم سبب هذه الأهمّية أن يوسّع المرء حقل رؤيته وأن يرى القرن الأفريقي كجزء من مبارزة استراتيجية أوسع لكسب النفوذ في الشرق الأوسط والبحر الأحمر وغربي المحيط الهندي.
أولاً، تعكس خطوط الصدع في القرن الأفريقي المحاور المتصلّبة لأزمة الخليج التي نشبت في العام 2017، وهي خلاف أثّر في عدد من المشاكل الإقليمية من سوريا إلى ليبيا إلى إيران ويشوبه أحياناً تصادم أيديولوجي حول دور الإسلام في السياسة. ففيما يتجذّر حزب العدالة والتنمية الحاكم والتابع لأردوغان في الإسلام السياسي ويتماهى مع جماعة الإخوان المسلمين، يرى الإماراتيون الإخوان المسلمين خطراً وجودياً وسعَوا بالإجمال إلى خنق القوى الإسلامية في المنطقة.
وقبل الأزمة في العام 2017، كانت العلاقات السعودية والإماراتية مع تركيا معقّدة لكن أفضل مما يتمّ تقديره أحياناً. واستمرّ غياب الثقة حيال وجهتَي نظر مختلفتين: المخاوف حول دور تركيا في المنطقة وكيفية التعامل مع إيران. (رأت الدول الخليجية تركيا آنذاك كثقل موازنٍ سنّي لإيران، لكنّها اليوم منزعجة من تعاون أنقرة الجديد مع طهران، ولا سّيما في سوريا). في غضون ذلك، تملّكت حكومة أردوغان شكوكٌ حول موقف القادة السعوديين والإماراتيين من محاولة الانقلاب التي جرت ضدّه في العام 2016 لكنّها لم تكن في صدد التضحية بالاستثمارات الخليجية الضخمة. بناء على ذلك، استمرّت التبادلات العالية المستوى والتجارة والتعاون الاقتصادي الجديد في العام 2017. بيد أنّ كلّ ذلك تغيّر عندما هبّت تركيا للدفاع عن قطر في أيّام الحصار الأولى، فلم ترسل الطعام والمؤن والزوّار الرفيعي المستوى فحسب، بل جنوداً ومعدّات إضافيين إلى قاعدة عسكرية تركية تمّ افتتاحها مؤخراً خارج الدوحة.
ويبدو أنّ بعض الأتراك تقبّلوا هذه المنافسة الجديدة، بما في ذلك تجلّياتها في أفريقيا. لكنّ معظم الأتراك يبدي قلقه، بحجّة أنّ الأزمة مضرّة بتركيا ومضرّة باقتصادها ومضرّة بالمنطقة. ويعربون عن عدم ارتياح كبير حيال التموضع الاستبدادي للدول الخليجية المتخاصمة والأثر المُزعزع على الدول الضعيفة أصلاً في الشرق الأوسط وأفريقيا والتداعيات غير المتعمّدة للمخاوف المتشاطرة مثل النزعة التوسّعية الإيرانية. ويقول المسؤولون الحكوميون إنّ تركيا براغماتية أكثر في علاقاتها مع الخارج وعليها أن تكون كذلك. فقال لي أحدهم: “لا يمكننا أن نكون عاطفيّين… أو أن نركّز على بعض الإهمالات المتصوّرة”، في تلميح إلى الدول المتخاصمة الخليجية.
وتلوم أنقرة واشنطن أيضاً على الأزمة الخليجية، بحجّة علاقة الرئيس ترامب الوطيدة مع السعوديين وملاحظاته التي ردّدت الانتقادات الموجّهة لقطر في أوّل أيّام الأزمة، وهو خطاب يعتقد الأتراك أنّه أطلق يد الدول العربية المتخاصمة مع قطر للاستمرار بالحصار واللجوء إلى العمل العسكري ربّما. ويقول المعلّقون الأتراك إنّه بعدما أزكت الولايات المتحدة نيران الأزمة، تقع على عاتقها مسؤولية القيام بالمزيد لحلّ الخصام. ويتحسّرون على تعاون الإدارة الأمريكية الأوسع مع الرياض وأبوظبي وتل أبيب، وهي كتلة يعتبرونها تحاول إعادة رسم الشرق الأوسط بشكل مضلّل.
استطراداً، يتساءل المراقبون الأتراك أيضاً ما إذا لم يكن التوسّع السعودي والإماراتي في القرن الأفريقي آتياً بإذن من واشنطن فحسب، بل هو يتبع إرشاداتها أيضاً. بيد أنّ قراءة كهذه تضخّم إلى حدّ بعيد في تقدير اهتمام الولايات المتحدة في القرن الأفريقي، هذا فضلاً عن قدرة واشنطن على وضع حلفائها الخليجيين في خدمة مصالحها.
ويهزأ المسؤولون الأتراك، وبشكل خاص داعمو الرئاسة، من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واصفينهما بغير الديمقراطية وغير الليبرالية، فيما اعتبروا أردوغان صوت العدالة والحداثة، متحاشين النقاش حول نزعة بلادهم السلطوية. وقال أحدهم: “إنّه قائد ناجح يستمدّ شرعيّته من الانتخابات. إنّه شخص يوازن بين القيم الإسلامية التقليدية والمعتدلة والممارسة الليبرالية الحديثة”.
ويقول الأتراك على مختلف ميولهم السياسية إنّ ما يُعرف بـ”النموذج التركي”، الذي يقضي بالجمع بين الانتخابات الديمقراطية والقيم الإسلامية، يمثّل تهديداً وجودياً للأنظمة الملكية الخليجية. ويستشهد داعمو أردوغان باستطلاعات رأي تبيّن رئيسهم كالشخصية الأكثر شعبية في “الشارع العربي”، ويقارنون أردوغان، المدافع عن الإصلاح الشعبي في العالم الإسلامي بأمراء الخليج. بالتالي، يتمّ النظر إلى عداوات الحكام الملوك ليس كردّ فعل لانحياز أنقرة لصالح الدوحة أو بسبب روابطها مع جماعة الإخوان المسلمين فحسب، بل نتيجة انعدام الأمان في الأنظمة الملكية أيضاً، ولا سيما بعد ثورات الربيع العربي في العام 2011.
وبحسب الكثير من المراقبين الأتراك، ينظر الرئيس أردوغان إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نظرة ازدراء، وهو شعور تعزّزه تصوّرات بالنفوذ العدواني من الشيخ محمد بن زايد الإماراتي والتدليل من إدارة ترامب ومؤخراً عملية القتل الوقحة لجمال خاشقجي في إسطنبول. لكن الكثير من الأتراك يقولون إنّ أردوغان يسعى إلى الحفاظ على مساحة لإقامة العلاقات مع المملكة، وليس بالضرورة لولي عهدها الوقح.
أما الإمارات العربية المتحدة فحكاية أخرى. فالانقسامات بين أنقرة وأبوظبي أعمق، والنظرة إلى قائدها أكثر ازدراءً. وقد وصلت التوتّرات مع الإمارات العربية المتحدة إلى أوجّها عقب خلع الرئيس المصري وحليف تركيا محمد مرسي في العام 2013. وتعتقد المؤسسة التركية أنّ ما جرى مخطّطٌ مصدره وتمويله من أبوظبي. وفيما تبقى الادّعاءات ذات حدّة أدنى، يشير الكثير من المسؤولين الأتراك سراً إلى أنّ الإمارات العربية المتحدة كانت منخرطة أيضاً بمحاولة الانقلاب على أردوغان في العام 2016.
ويرفض المسؤولون الأتراك فكرة أنّ تركيا تريد التنافس مع الإمارات العربية المتحدة في القرن الأفريقي أو البحر الأحمر أو أيّ مكان آخر. فيردّد كلّهم السؤال ذاته: “لماذا نهتمّ في أمر كهذا؟” وينزعجون من الاقتراح بأنّهم منشغلون بدولة صغيرة ذات “ثروة جديدة” مثل الإمارات العربية المتحدة، فتركيا حضارة ذات شأن تكسب قوّتها من التاريخ والحجم والأهمّية الثقافية. لكنّ ناشطي السياسة الخارجية في أبوظبي يستأثرون بمستوى انتباه في أنقرة أكثر ممّا تودّ الإقرار به.
ويتمّ النظر إلى الجيل الجديد من الشيوخ، أي بن زايد وتلميذه المتصوّر بن سلمان، على أنهما “متهوّران” و”عدائيان” وأنّ حملات النفوذ المدعومة بالمال التي يطلقونها مصمّمةٌ لشراء الأفراد وسحق القوى الإصلاحية. وقال مسؤول تركي باحتقار: “يجري الكثير من الرشاوى وتأجيج الصراعات وغيرها من النشاطات المشبوهة. سترتدّ هذ السياسة عكسياً، ولن تنجح في النهاية”.
في المقابل، العلاقات التركية القطرية في أفضل حالاتها. ويقول المسؤولون الأتراك إنّ العلاقة مع الدوحة لم تكن “مميّزة بشكل خاص” قبل الأزمة، وتقرّ كلتا الجهتين ببعض نقاط الاختلاف اليوم. لكن في الوقت الراهن، يشكّل جوهر العلاقة التلاقي والعلاقات التجارية المحسّنة والنقاط المشتركة الإيديولوجية والتناغم بين أردوغان والأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. (ويتمّ التغاضي طبعاً عن واقع أنّ قطر، شأنها شأن الدول الخليجية المجاورة، هي بلد بنظام حكم ملكي.)
وشرح موظّف مدني رفيع المستوى عن التضامن التركي في خضمّ الحصار على الدوحة قائلاً: “سياسيّونا عاطفيون للغاية. سينجدون دائماً الجهة المستضعفة. وينبع ذلك من إحساس بإحلال العدل”. وينبع كذلك من ظمأ للنقود. وهو أمر كانت الدوحة طبعاً جاهزة لتقديمه في محاولتها لاستقطاب حلفاء أقوياء. وعلاوة على مساعدة تركيا على مواجهة أزمة العملة التي تعانيها، ضخّ الأمير القطري رأسمالاً بقيمة 15 مليار دولار في العام 2018 كبادرة شكر للدعم الذي قدّمته تركيا في الوقت المناسب.
بيد أنّ المسؤولين الأتراك يرفضون الادّعاءات القائلة إنّ قاعدتهم العسكرية الجديدة في قطر تمثّل تهديداً للدول الخليجية المجاورة، قائلين إنها أتت نتيجة اتفاقية موقّعة في العام 2014، قبل ثلاث سنوات من اندلاع الأزمة الخليجية. ويعتبرون هذه الادعاءات مراوغة، لكنّ المراقبين الخارجيين والمحلّيين على حدّ سواء يقولون إن أنقرة لم تفهم بشكل صحيح التداعيات التي تولّدها اتفاقية إنشاء القاعدة، أو على الأقلّ لم تقدّر كيف سيكون ردّ فعل الرياض وأبوظبي تجاه انتشار جنود أتراك في مناطق قريبة منهما.
نظرة واسعة الزاوية: سياسة خارجية أم سياسات داخلية؟
تتبوأ أولوياتِ السياسة الخارجية التركية سوريا ومنطقةُ البحر المتوسط والعلاقاتُ المعقدة مع الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا (بما في ذلك الدخول إلى الاتحاد الأوروبي) وتسويقُ أسلوبها الخاص من العمل السياسي الديني في منطقة الشرق الأوسط المتغيرة. ويأتي القرن الأفريقي في مرتبة أدنى، لكنّه ما دام مرتبطاً بسياق استراتيجي أوسع، يرى أخصام تركيا خطوات أردوغان في المنطقة على أنها دليل على أجندة “عثمانية جديدة” خطيرة، وكثيرة هي الخطابات التي يطلقها أردوغان والتي تدعم هذه الادعاءات.
وفيما يتّسم الحنين العثماني بطابع استفزازي ظاهري، هو موجّه أكثر للاستهلاك المحلّي كنقطة حشد قومية للهوية التركية في زمن من الاضطراب وركن من أركان الأسلوب الشعبوي المتباهي الذي يعتمده أردوغان. ويقول خبير تركي: “لهذا الخطاب قيمة عاطفية على الصعيد المحلّي، لكنّه لا يمثّل مسعى حقيقياً في السياسة الخارجية”.
لكنّ هذا التفصيل الصغير ليس واضحاً للجميع في الخارج، وذلك نتيجة مزيج معقّد جداً من السياسات المحلّية والسياسة الخارجية المُعتمدة في ظلّ حكم أردوغان.
وفي أعقاب الربيع العربي، بدا “النموذج التركي” صاعداً. فلأردوغان، ستساعده دولة تركية قوية وديمقراطية ومزدهرة على كسب المزيد من النفوذ في الخارج، وهذا بدوره يساعده على ترسيخ شعبية أردوغان الذي لا يتوقّف عن القيام بالحملات في تركيا. لكنّ الوضع في الشرق الأوسط يبدو مختلفاً الآن بعد مرور ثماني سنوات، وأهلية تركيا الاقتصادية والديمقراطية تبدو مختلفة أيضاً.
وما زال طموح أردوغان بالتربّع على عرش عالم مسلم منشّط سارياً، وعلى الأرجح أن تستمرّ نشاطات القوّة الناعمة. لكنّ المخاوف حول الفتوحات الاستعمارية الجديدة أو حتى فتوحات الأراضي مضخّمة. وقد يصبح التفريق بين هذه التفاصيل أصعب من قبل، ويتطلّب تفسير السياسة الخارجية التركية، بما في ذلك في القرن الأفريقي، نظرة معمّقة إلى ما هو داخل الحدود التركية حيث يجدر أخذ ثلاث ديناميات بعين الاعتبار.
أولاً، تجميع القوة في منصب الرئاسة التركية الجديد، وهذا أحدث تطوّر في منحى التراجع المستمر في الديمقراطية الذي تشهده البلاد. فعقب فوز انتخابي كبير في العام 2018، سرعان ما باشر أردوغان بتحويل نظام برلماني عمره يناهز القرن إلى نظام رئاسي مركزي جداً. فتَركّز صنع السياسات الخارجية في القصر الرئاسي أيضاً، فيما أُبعِد الجيش ووزارة الخارجية وغيرهما من المؤسّسات المهمة إلى الهامش.
وأحيلت وزارة الخارجية إلى العمل كـ”وكالة تطبيق” فيما استلم مستشارو أردوغان، من ضمنهم مجلس أمن وسياسة خارجية مؤلّف من 11 عضواً، زمام وضع السياسات. وجرى ذلك بعد أن أقال أردوغان قرابة 25 في المئة من الدبلوماسيين من وزارة الخارجية، في انعكاس لعمليات تخفيض حكومية أوسع ضدّ المعارضين السياسيين المتصورين، وأعدادهم تصل إلى عشرات الآلاف، عقب محاولة الانقلاب في العام 2016. (كان الكثير ممّن أقيلوا يلقّبون بـ”الغولنيين”. وطالت تداعيات محاولة الانقلاب هذه القرن الأفريقي أيضاً حيث تمّ تطوير الكثير من الروابط الأولية في مجالات الأعمال والتعليم والمنظمات غير الحكومية على يد أولئك ذوي الصلات بالمتّهم بالتخطيط للانقلاب وغريم أردوغان فتح الله غولن. فأقفل عدد كبير من المدارس بإدارة تركية فوراً بسبب انتمائها الغولني قبل نقل الإدارة لتصبح في يد مدراء مرتبطين بالحكومة).
ثانياً، وضع الاقتصاد التركي متأزّم، مما يترك الرئيس القوي مكشوفاً في الموضوع الوحيد الذي قد لا يتمكّن من إخضاعه لإرادته. فبعد سنوات من النمو الملفت، أفضت الإدارة الاقتصادية التفصيلية الرديئة والتغييرات المؤسساتية الكاسحة التي أدخلها أردوغان إلى ركود كبير في الصيف الماضي. وتفاقم الوضع عندما انهارت الليرة التركية بشدّة، وهو سقوط حاول أن يلقي أردوغان اللوم لحدوثه على متآمرين أجانب. فانخفضت ثقة المستثمر وارتفعت البطالة والتضخّم والأسعار بشكل هائل. فتمّ التخفيض من الموازنات التشغيلية وتخصيصات المساعدات الإنسانية، وهذا مجال كانت فيه تركيا في الصدارة سابقاً، وتمّ الحدّ من الأجندات على جميع أنواعها، بما في ذلك السياسة الخارجية.
أما الدينامية الثالثة، فهي هوس أردوغان: الانتخابات. سيعتمد المدى الذي إليه يستطيع أردوغان أن يمدّد نفسه في الخارج جزئياً على تخطّي الشكّ السياسي (بما في ذلك التشكيك في سياسته الخارجية) ومنح الاستقرار للاقتصاد في البلاد. وأدّت الانتخابات البلدية التي جرت على صعيد البلاد بأسرها في الربيع والتي تحوّلت إلى استفتاء لحكم أردوغان إلى تعرّض حزب الرئيس لهزائم بارزة، من بينها هزائم في أنقرة وإسطنبول. (تمّ إبطال نتائج التصويت في إسطنبول بضغط من أردوغان). علاوة على ذلك، أرغم أردوغان على القيام بخطوات صارمة، وبعضهم يقول إنها قصيرة النظر، لمحاولة تدعيم الاقتصاد قبل التصويت، وقد يخلّف ذلك هوّة أعمق ينبغي الخروج منها. فهل سيولي الرئيس انتباهاً أكبر في الداخل لمعالجة هذا التحدّي، أم سيلجأ مرة أخرى إلى شعبوية السياسة الخارجية للمساعدة على التعافي السياسي؟
يحاول أردوغان جعل تركيا قوّة إنسانية من الصومال إلى سوريا وملاذاً مرحِّباً لنازحي العالم. ووضع نفسه في موقع المدافع عن المستضعفين في الطبقة العاملة في العالم المسلم ومدافع أخلاقي عن مجتمعاتها المحاصرة، من فلسطين إلى كرايست تشيرتش. ويكسبه وقوفه في وجه الغرب وإسرائيل والأنظمة الملكية الخليجية الثناء في قواعد انتخابية كبيرة. بيد أنّ النقّاد يقلقون من أنّ كلّ هذا التبجّح لا يفضي إلى استراتيجية متماسكة، ولا سيما وسْط الاضطرابات وتردّي الديمقراطية في تركيا.
يحتاج تقييمٌ مناسب للطموحات التركية ولتأثير تركيا في القرن الأفريقي إلى نظرات قريبة ومتوسّطة وواسعة الزاوية. قد لا يكون القرن الأفريقي مسألة ذات أولوية عالية في سياسة أنقرة الخارجية. وهذا أمر، عند اقترانه بالانطواء السياسي التركي وفورة من الاهتمام من الدول المنافسة الخليجية، يمكنه أن يقلّل من الأفضلية المقارنة لأنقرة في المنطقة، أقلّه على المدى القريب. ولا ينبغي التقليل من أهمّية استثمارات تركيا السياسية والاقتصادية في القرن الأفريقي ولا ينبغي التقليل من أهمّية حضورها المستمرّ هناك أيضاً، نظراً إلى السياق الجيوسياسي الأوسع. ولكن في الوقت الراهن، تركيا تبحث عن هويّتها، في الداخل والخارج.