من أكثر المواقف غموضًا في السنوات الأربع الماضية هو كيف أن الرئيس باراك أوباما – الذي أتى إلى منصبه جزئيًا بسبب وعوده بإعادة التفكير في السياسة الأمريكية بشكل جذري وإعادة توجيهها في الشرق الأوسط – ظل يهرب من المنطقة طوال فترة رئاسته.
إن من الصعب أن نتذكر ذلك الآن ولكن العالم العربي قد رحب في البداية برئاسة أوباما مع شيء من الارتياح والتفاؤل الحذر ساهم في ذلك بالطبع اسمه ونشأته المسلمة؛ ولكن هناك شيء آخر: لأول مرة يوجد رئيس أمريكي يبدو أنه يتفهم مظالم العرب وقد امتد هذا الفهم للصراع العربي الإسرائيلي وهو الأهم. وبإيجاز، بدا أوباما أنه “يفوز” بالشرق الأوسط وهو لا يبدو مثل شخص أراد أن يقضي ثلاث سنوات “مرتكزًا” على الصين.
إذا عدنا إلى تصريحات أوباما المختلفة قبل أن يصبح رئيسًا نجد أنها مصدمة نوعًا ما. ففي حفل الوداع للعالم المناصر للحقوق الفلسطينية راشد خالدي الذي أقيم في 2003، صرح أوباما للجمهور أن محادثاته مع خالدي كانت “رسائل تذكير لي بعدم رؤيتي وانحيازي… لذا فإنني أؤمل في أن نستمر في المحادثة لسنوات عدة تالية. ويذكر الصحفي الفلسطيني الأمريكي علي أبو نعمة تصريح أوباما له في 2004: “أعتذر لأنني لم أذكر الكثير عن فلسطين الآن ولكننا في سباق مهم وصعب، وآمل حينما تهدأ الأمور أن أكون أكثر صراحة”. (أنكرت الحملة إدلاء أوباما لهذه التصريحات).
من السهل جدًا أن تقدم الكثير من مثل هذه التعليقات لأنه تم تقديم الكثير منها بالفعل, ولكن هناك شك في أن أوباما قد تميز عن الرؤساء السابقين في طريقة تفكيره وحديثه عن الصراع العربي الإسرائيلي. علاوة على ذلك، فإنه أدرك أن تركيز الصراع بالسرد العربي الأوسع. وكما أخبر جيفري جولدبيرج في 2008، “هذا الجرح المستمر…هذا الحزن المستمر يلحق بجميع سياساتنا الخارجية”. حتى بعد أن أصبح أوباما رئيسًا، أعترف أوباما بتاريخ أمريكا المتقلب والمفزع في بعض الأحيان في المنطقة. وفي خطابه الذي ألقاه في القاهرة في 2009، ألمح أوباما إلى أن التوتر بين الغرب والإسلامي مؤكدًا أنه “يغذيه الاستعمار الذي أنكر حقوق وفرص العديد من المسلمين وحرب باردة عوملت فيها أغلبية الدول الإسلامية كتابعين دون النظر إلى تطلعاتها الخاصة”.
إن السؤال الذي يطرح نفسه ليس هو ما إذا كان هذا الرأي جيد أم سيئ. فبغض النظر عن وصفه، كان أوباما يؤمن بشكل واضح باستعادة القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط، وكانت هذه القيادة – من خلال التوسع – ذات أهمية ويمكن أن تستخدم للأبد. وفي السنوات التالية، يبدو أن أوباما قد فقد تدريجيًا الثقة بقدرة الولايات المتحدة في التأثير على مجرى الأحداث.
عقب اندلاع الانتفاضات العربية، أصر مسؤولون أمريكيون بصفة عامة وخاصة على أن ذلك “ليس بشأن أمريكا”. إن مشاركة الأمريكيين جاءت في أحيان كثيرة ضد روح لحظة الإصرار الذاتي وهو تفكير مأمول: من بين الثورات العربية الخمس والثورة التي باتت قريبة في البحرين، لعب ممثلون خارجيون دورًا حاسمًا في أربع منهن. ولكن في ظل غياب إستراتيجية كبيرة، بدت ولا تزال إدارة أوباما تدفعها الرغبة نحو تقليص تأثيرها في الشرق الأوسط.
وفي سوريا، ساهم الغياب الغامض للقيادة الأمريكية في التأكيد على الصورة التي لا تزال تبدو عليها الولايات المتحدة. فبدون قيادة أمريكية في هذا الصدد، سيأخذ العديد من السوريين “القيادة من الوراء” – وقد بات الصراع الذي استمر 19 شهرًا خارج السيطرة. احتجت تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية من أجل بذل المزيد من الجهود لدعم الثوار السوريين ولكنهم لن يقومون بذلك بدون غطاء أو دعم أمريكي. كانت إدارة أوباما قد حبطت بشكل كبير من همة حلفائها بمد الثوار بالأسلحة التي يقولون أنهم يحتاجونها لإقصاء نظام بشار الأسد. وقد صرح عضو مجلس ثوري لإحدى المدن قائلاً :”سنقرأ في وسائل الإعلام أننا نتلقى شيئًا بالرغم من أننا لم نر شيئًا. فنحن لا نتلقى سوى خطابات من الغرب”.
السجل في مكان آخر ليس بالأفضل وقد لاحظ العرب ذلك. إن الشيء الذي يلفت النظر هو أن تصنيف التأييد الأمريكي في العديد من الدول العربية أقل في إدارة أوباما مقارنة بنظيره السابق بوش.
وبدلاً من تقديم الدعم الواضح والمتوافق للانتفاضات العربية، اتسم رد إدارة أوباما بما أطلق عليه “التغطية العنيفة”. ومن ثم، نجحت الولايات المتحدة نوعًا ما في تحريك جانبي الحرب الباردة العربية: يعتقد الديكتاتوريون أننا مؤيدون للثورة، ويساور المتظاهرون العرب والثوار القلق من استمرار مساندتنا للديكتاتوريين.
لكي نكون على يقين، فإن هذه المشكلة تسبق السنوات الأربع الأخيرة. لم يكن أوباما، الذي كان معارضًا لبوش، مؤيدًا على الإطلاق للوضع الأكثر عنفًا المناصر للديمقراطية في المنطقة. ولكن في ظل اتساع نطاق الانتفاضات، ورغبة في أسر حب الملايين من الأمريكيين، ظلت إدارة أوباما غير راغبة في أن تدخل في شروط مع الواقع الجديد. وفي النقاش الرئاسي الثالث في مدينة بوكا راتون، صرح أوباما أن الولايات المتحدة وقفت بجانب الشعب التونسي “في وقت مبكر قبل أي دولة أخرى” وهو غير صحيح على الإطلاق: في الساعات الأخيرة من يوم 12 يناير، وقبل يومين فقط من الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أكدت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية – مرتين – أن الولايات المتحدة “لم تكن تتخذ خطوات”.
إذا أخذنا في الاعتبار كارثة الحرب في العراق، فقد يكون من المستحيل تقريبًا أن نقتنع أن سجل أوباما عن الشرق الأوسط أسوء من سلفه. ولكن من الواضح أن الرئاسة التحولية التي ألمح إليها أوباما كمرشح – وفي خطابه بالقاهرة – قد كونت صورة له. وقد عرض الربيع العربي هذه اللحظة التحولية مانحا الولايات المتحدة فرصة ثانية لتوازن مصالحها وقيمها مع طموحات عامة العرب. وكما أحدثت هجمات 11 سبتمبر ارتباكًا لدى إدارة بوش مانحة إياه معنى أعمق للهدف (للأفضل أو الأسوء) كان من الممكن للمرء أن يتصور أن الثورات العربية تسير في نفس الاتجاه. ولكن يبدو أن الأحداث المهمة التي وقعت في العامين الماضيين كان لها أثر عميق على نظرة الرئيس المستقبلية.
لهذه الأسباب وغيرها من أسباب كثيرة، من غير المرجح أن تتغير الفترة الرئاسية الثانية لأوباما عن الأولى التي اتسمت بالحذر والتمعن. وفي الشرق الأوسط، من الراجح أن يستمر الدافع الأساسي – والمشاركة حيثما وجب ذلك والإحجام عندما نستطيع.
وماذا عن الصراع العربي الإسرائيلي؟ إذا كان هناك جانب بدا فيه أوباما متحمسًا بشكل خاص فإنه هذا الجانب. فبعد مضي 3 أيام على توليه الرئاسة، عين السيناتور السابق جورج ميتشل مبعوثًا خاصًا – وهو القرار الذي اعتبر إشارة إلى جدية الإدارة في إحداث تقدم. وإذا كان الصراع قد أفسد كل شيء، كما قال أوباما، فإن الطريقة الوحيدة لصياغة “بداية جديدة” مع العالم العربي كانت من خلال سلام عادل. ولكن منهج الإدارة سرعان ما فشل: فالتركيز فقط على وقف بناء المستوطنات كان له مردود عكسي وأشعل غضب الحكومة الإسرائيلية مع عدم الاهتمام بالقضايا الفلسطينية كالحدود وحق العودة ووضع القدس.
لقد نجحت الإدارة الأمريكية مرة أخرى نوعًا ما في استبعاد الإسرائيليين والفلسطينيين بمكيال واحد تقريبًا. وحدث الضرر حتى وبعد سحب إدارة أوباما وزيادة التعاون الأمني مع إسرائيل لمستويات غير مسبوقة. لم يثق عدد كبير جدًا من الإسرائيليين في أوباما حيث اشتبهوا أنه كان بالتأكيد متعاطفًا مع القضية الفلسطينية. والغريب أن ذلك ما كان يعتقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس – ما أدى إلى شعور بالخداع. وفي لقاء مع نيوزويك، بدا وكأنه يطرح نفس السؤال على عقول العديد من العرب: ما الذي حدث لأوباما. “صرح عباس قائلاً “لقد عرفناه قبل أن يصبح رئيسًا، عرفناه وكان مستمعًا جيدًا”.
في الفترة الرئاسية الثانية، لا يوجد مبررات كثيرة تدفعنا للقول بأن أوباما سيحالفه نجاح أكبر في قضية الصراع العربي الإسرائيلي؛ فالجانبان بعيدان كل البعد. ومن الصعب أن نتخيل أن التحالف الجديد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واليميني المتطرف أفغدور ليبرمان يقدم التنازلات التي يطلبها الفلسطينيون لضمان التوصل لاتفاق نهائي. وفي ظل تركيز أوباما بشكل أكبر على شرعيته أكثر من انتخابه مرة ثانية، هل من الممكن أن يكون لديه الرغبة لممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل في الفترة الثانية؟ ولكن لا يوجد لأي جانب حتى الآن الكثير من المصالح لتكرار سيناريو 2009 و2010 فقد تم فقد الثقة وتبديد الرأسمال السياسي.
وكما أن أوباما لا يحظى بشعبية في العالم العربي، فإن ميت رومني غير محبوب أيضًا. والأفضلية لا تنحاز لأي منهما. وبالرغم من معاداة الأمريكيين الواضحة إلا أنه يوجد بصيص من الأمل فلا يزال هناك تعطش للقيادة الأمريكية في العالم العربي يرجع بعضها إلى الإيمان العميق بشركاء أمريكيين أفضل بعضها بسبب عدم وجود أي شخص آخر يمكن اللجوء إليه. وقد طلبت – وناشدت في بعض الأحيان – مصر والبحرين وليبيا والآن سوريا من أمريكا وقت الحاجة أن تدعم جهودها ولكنهم لن ينتظرون للأبد.
إن نجاح وإخفاق أوباما وما كان يبدو أنه يمثله يترك أثر الحزن عليه. ربما يكون المنصب قد أغراه بالتحول وليس الطريقة. وكما قال المحرر جرانس فرانك روتا :”لم يعد مهمًا الحديث عن شخصية أوباما حينما تم انتخابه رئيسًا بعد شن حربين، الحرب الأكثر طلاقة ضد القاعدة، أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، والحروب الطاحنة المستمرة مع الجمهوريين بواشنطن”.
مهما كانت الأسباب، فإن النتيجة واحدة وهي ضياع الفرصة. ولكن يوجد فرصة، كما هو الحال دائمًا، لإصلاح الخطأ، لتبني منهج “التدرج” بوصفه أفضل الخيارات السيئة في عالم معقد يتسم بالفوضى، ولكن ليس هذا الذي كنا نحتاجه منذ أربع سنوات، وليس ما نحتاجه الآن أيضًا.
Past Event
February
22-23
2016
U.S. Government & Politics
ماذا تعني الانتخابات الرئاسية الأمريكية للشرق الأوسط؟



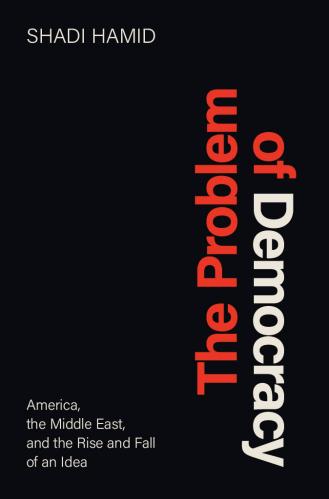
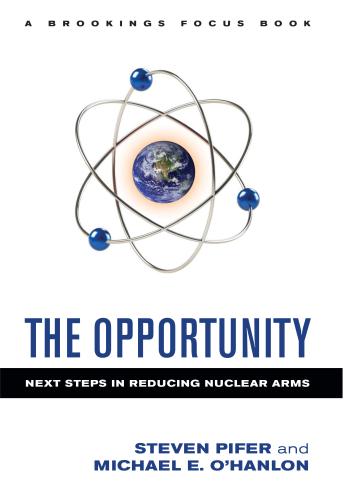
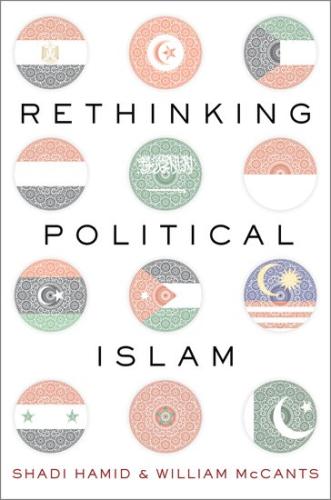


Commentary
الشرق الأوسط يخسر
November 5, 2012