فيها الكثير ممّا يدعو للاستياء، إن كنت فلسطينياً. فبمجرّد قراءة الصفحات القليلة الأولى من الخطّة، لا يمكن أن يتوقّع المرء بشكل منطقي أن يرى أيُّ فلسطيني أيَّ أمر إيجابي بين سطورها. ولا يجدر أن يكون الأمر مفاجئاً. فمقدّمة الخطّة تقتبس من خطاب رئيس الوزراء إسحق رابين الذي ألقاه في أكتوبر 1995 أمام الكنيست، وسعى فيه إلى كسب الموافقة لاتفاقية أوسلو المؤّقتة الثانية عبر طرح رؤيةٍ لكيان فلسطيني مستقبلي وصفَه بأنّه “أقلّ من دولة”. وكان لهذا الاقتباس أثرٌ عميق فيّ.
فماذا يمكن أن يستنتج المرء من خطّة تشدّد على أنّ القيادة الفلسطينية لم ترفض رؤية رابين آنذاك؟ علاوة على ذلك، وكأنّ النقطة التي يحاول مؤلّفو الخطّة تسليط الضوء عليها لم تكن واضحة بما فيه الكفاية، حرصوا على التشديد على أنّ رؤية رابين كانت واضحة في أنّ “القدس تبقى موحّدة تحت الحكم الإسرائيلي وأنّ الأقسامَ التي تضمّ عدداً كبيراً من اليهود في الضفّة الغربية ونهرَ الأردن تتبع لإسرائيل وأنّ غزّة وما يبقى من الضفّة الغربية يخضعان لاستقلالية فلسطينية… في ما يشكّل أقلّ من دولة”. ومع اعتناق رؤية ترامب أسس رابين هذه، يشير واضعو الخطّة بوضوح إلى أنّ الرفض الفلسطيني المتوقَّع على صعيد واسع للخطة غير مبرّر.
في المسألة الكثيرُ من النقاط. بدايةً، التأكيد على أنّ القيادة الفلسطينية لم ترفض رؤية رابين لا يعني أنّها قبلت بها. مع ذلك، ما وقّعت عليه تلك القيادة بموجب إطار عمل اتفاقية أوسلو كان مجرّد استقلالية، ولا ينطبق ذلك إلا على أقسام الأراضي الفلسطينية التي احتلّتها إسرائيل في العام 1967. لكنّ الفلسطينيين ظنّوا أنّه بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات سينالون دولة يمكنهم أن يعتبروها بفخر وطناً لهم. ولم يكونوا الوحيدين الذين ظنّوا ذلك. فسواء أكان على أسس العدالة أم الشرعية أم الوضع العملي أم مزيج من هذه العناصر كلها، برز بالفعل توافق دولي واسع، من ضمنه في إسرائيل أيضاً، لصالح رؤيةٍ لدولتين يستطيع الإسرائيليون والفلسطينيون على حدّ سواء التعايش معها. وهذا باختصار ما سعت محاولات الوساطة المختلفة بقيادة الولايات المتحدة إلى تحقيقه منذ اتفاقية أوسلو لكن فشلت.
من دون الكثير من التحليل، يقترح واضعو الخطّة أنّ جهود الوساطة الماضية فشلت لافتقارها إلى الشموليّة وغياب محتوى اقتصادي حقيقي فيها ولعدم مراعاتها الحقائق الطاغية على نحوٍ كافٍ. وفيما تختلف أسباب الفشل، التفسيران الأولان اللذان يطرحهما واضعو الخطة هما موضع شكّ.
فمن ناحية، يتجاهل التأكيد على الافتقار إلى الشمولية سجلَّ المفاوضات المكثّفة والعمل المفصّل في خلال جولات الوساطة والدبلوماسية المتعاقبة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. من ناحية أخرى، من الجدير التذكّر أنّ إطار العمل الثلاثي (الذي يضمّ إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومجتمع الدول المانحة الدولي) كان مرتكزاً، منذ نشأة السلطة الفلسطينية، على مكوّن ضخم محوره الاقتصاد وبناء القدرات الفلسطينية.
أما في ما يخصّ التفسير الثالث لواضعي الخطّة، يوحي تأطير خطّة إدارة ترامب واللغة المحدّدة التي تعتمدها أنّ ما أرادت الخطّة قوله فعلاً هو أنّ الجهود السابقة لم تعطِ الأولوية بما فيه الكفاية للخطاب الإسرائيلي، أو بشكل أدقّ، أنّها لم تعتنق بالكامل آراء أقصى اليمين الإسرائيلي. قد يبدو ذلك تصريحاً قويّ اللهجة، لكن في الواقع، تتأكّد صحّته من خلال اختزال الخطّة لحقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، إن لم يكن من خلال تجاهل الخطاب الفلسطيني برمّته.
وبالفعل، تفرض الخطّة بشكل محدّد أن يقتصر تطبيق حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على “مسار نحو حياة وطنية كريمة”، مع بقاء إسرائيل الدولة الوحيدة التي تتمتّع بسيادة وسيطرة كاملتين على كامل المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن. ويبرز بشكل لافت في هذا الخصوص تخصيص نهر الأردن ومناطق أخرى من الضفّة الغربية لعملية ضمّ إسرائيلية، مع صلاحية إجرائها وقتما ترى الأمر مناسباً طبعاً، علماً أنّ هذه المناطق مهمّة لاستمرارية أيّ دولة فلسطينية عتيدة. علاوة على ذلك، فيما تشدّد الخطّة على احترام “أهميّة المنطقة التاريخية والدينية بالنسبة لشعبها”، يشكّل إصرار الخطّة على بقاء القدس موحّدة تحت السيادة الإسرائيلية التامّة نقطة أخرى في هذا السياق.
لكن تبرز مشكلة أخرى هي المحاولة غير المبطّنة لتجريد مسألة اللاجئين الفلسطينيين من أيّ بُعد سياسي. فعلاوة على نكران الخطّة الصريح والأكيد لحقّ العودة للاجئين، تستثني الخطّة أيضاً وبشكل قاطع إسرائيل كوجهة عودة ممكنة. وتضع كذلك قيوداً على النطاق الذي يمكن أن تكون “دولة فلسطين” فيه وجهةَ عودة وتعطي إسرائيل حقّ النقض في هذا الموضوع، زد على ذلك أنّها تحدّد إمكانية تقديم تعويضات مباشرة.
علاوة على ذلك، تعجّ الخطّة بأمثلة واقتراحات أخرى بشأن أيّ خطاب ينبغي أن يطغى. ويشمل ذلك الاقتراح بأن لا حقوق للفلسطينيين بالأراضي بأيّ شكل من الأشكال، كما هو مُلمّح بوضوح في إشارة الخطّة إلى “تعيين” الأراضي “التي فرضت إسرائيل عليها أحقّية قانونية وتاريخية صالحة” لدولة فلسطينية عتيدة. ويشمل أيضاً التوقعات بالحصول على الحقّ الفردي عند ترسيم الحدود، ويخضع ذلك للمحاكمة في النظام القضائي الإسرائيلي والحدّ من نطاق الدولة الفلسطينية في التخطيط والتقسيم في المناطق المحاذية لحدودها مع إسرائيل، من دون اقتراح حتّى أي قيود على المجال الإسرائيلي لنقض القرارات الفلسطينية في هذا الخصوص.
وتضمّ الخطة نواحي أخرى مقلقة جداً للفلسطينيين عموماً، ولكنّها مقلقة للغاية لمَن هم مواطنون في دولة إسرائيل، أقلّه في ناحيتين. وترتبط الناحية الأولى بما يبدو إقصاء متعمّداً للحقوق السياسية من مجال حقوق المواطنة المحمية، فيما ترتبط الثانية باقتراح جعل ضمّ “المجتمعات المثلّثة” إلى دولة إسرائيل غيرَ مشترط بموافقة سكّان المنطقة.
فإن لم تكن العيوب الهيكلية الخطيرة المطروحة أعلاه سبباً كافياً لرفض الفلسطينيين رؤيةَ ترامب، فكّروا في التالي. على عكس العام 1995، لا يمكن أن ينتاب القيادة الفلسطينية أيّ شكّ في هذه اللحظة بأنّ العرض المقدّم لا يتمحور إلا حول “دولة ناقصة”. والأسوأ أنّني لست أكيداً أنّ هذا سيحدث، لا بل إنّها الفرصة لخوض رحلة تأهّل مدّتها أربع سنوات بحثاً عن “الدولة الناقصة”، فيما تسجّل إسرائيل والولايات المتّحدة معاً نتائج الجهود الفلسطينية في مجال الحوكمة بالإجمال وفيما تكون إسرائيل وحدها الحكم النهائي لأداء الفلسطينيين في مجال الأمن.
وعند التفكير في إعادة إحياء الخطّة لـ”المبادئ الرباعية”، بالتزامن مع بيانها بأنّه ينبغي تجريد حركة حماس من سلاحها في غزّة كشرط ضمن إطار عمل هذه المبادئ، يستطيع المرء أن يرى بسهولة أنّه عوضاً عن طرح “مسار نحو حياة وطنية كريمة” (أو “دولة ناقصة” بتعبير أقلّ إحساناً)، يشكّل هذا الشرط المُسبق المطروح طريقاً لا يؤدّي إلى مكان. حتّى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كاد يقول ذلك في 28 يناير عندما أعلن بتبجّح، واقفاً بجانب رئيس الولايات المتحدة: “أعلم أنّ الوصول إلى نهاية هذا المسار سيتطلّب [من الفلسطينيين] وقتاً طويلاً جداً”. وهذا الأمر صحيح، حتّى لو كانت نيّة رئيس الوزراء تأمين أكثرية يمينية في الانتخابات الإسرائيلية القادمة لا أكثر، خوفاً من أنّ قاعدته الانتخابية في إسرائيل لن تشعر بالاطمئنان لإحالته مسألة إقامة الدولة الفلسطينية إلى مفاوضات لا تنتهي.
وتمنح كلّ هذه العناصر أساساً إلزامياً لرفضٍ فلسطيني لرؤية ترامب. لكن لا يجوز النسيان بأنّ رفضاً كهذا، بحدّ ذاته، لا يُسقط أهمّية الرؤية. ولهذا لا يجوز أيضاً الخلط بينه وبين استراتيجية رفض. فاستراتيجية كهذه تفترض تقييماً ذكياً للمخاطر الوجودية التي تواجهها الحركة الوطنية الفلسطينية وتحديداً مُطّلعاً للخيارات المتاحة في السياسات والإرادة اللازمة للعمل على تنفيذها.
سيكون تصرّف كهذاً عملاً قيادياً يفسِّر غيابُه في عدّة مراحل مفصلية على مدى القرن الماضي أسبابَ الإخفاقات الفلسطينية أكثر ممّا يفسر مجرّد الرفض للرؤى أو الخطط الماضية. ومن البديهي القول إنّ الجهد الفلسطيني من الآن فصاعداً لا ينبغي أن يتقيّد على الإطلاق بالعبء الكبير الذي يولّده الخطاب المرتكز على مقولة إنّه “كلّما قال الفلسطينيون لا، خسروا”. مع ذلك، لم نبلِ بلاء حسناً أيضاً في المرّات الكثيرة التي قلنا فيها “نعم”، ولا سيّما منذ العام 1988.
ومن الطرق التي يمكن أن تكتسب فيها رؤية ترامب تداعيات كارثية على المدى القريب هو الاحتمال البعيد أن تعمل بالاستناد إلى الضوء الأخضر الذي منحته هذه الرؤية لضمّ الأراضي الحيوية لاستمرارية الدولة الفلسطينية. وفيما صُوّرت هذه الخطوة بداية على أنّها وشيكة، يبرز التباسٌ الآن حول التاريخ الذي سيتمّ تنفيذها فيه. بيد أنّ الخطّة بحدّ ذاتها لم تربط على الإطلاق الضمّ الإسرائيلي بالمفاوضات أو أيّ معيار آخر حتّى. بالتالي، قد يتمّ الضمّ في أيّ لحظة من اللحظات، وعلى الأرجح أن يجري ذلك عاجلاً وليس آجلاً. ويشير ذلك إلى حاجة الفلسطينيين الجلية إلى الجعل من وقف حملة الضمّ الإسرائيلية أولويةً، وذلك كمسألة غاية في الإلحاح، في خضمّ وضْعهم استراتيجيةَ رفض فعّالة.
ولا داعي ولا ينبغي تأطير استراتيجية كهذه من ناحية جهوزية الفلسطينيين للانخراط إقليمياً ودولياً على أساس رؤية ترامب. عوضاً عن ذلك، يمكن أن تأخذ هذه الاستراتيجية شكل عملية إطلاق لمبادرة فلسطينية تستفيد من الإشارة المتكرّرة في الخطّة إلى “المسائل التي ينبغي حلّها في النهاية عبر المفاوضات بين الفريقين نفسيهما”، وذلك من أجل منع إمكانية قيام إسرائيل بأيّ عملية ضمّ قبل إتمام المفاوضات. وبإمكان هذه المبادرة أن تضع برنامجاً فلسطينياً مدّته أربع سنوات لعمل يرتكز على دعم قضية التمكين الفلسطيني، بدءاً من توحيد نظام الحكم الفلسطيني، وهذا شديد الأهمية، وتعزيز مؤسّسات الحكومة الوطنية وعملياتها. وسيتطلّب ذلك لقاء فورياً للإطار القيادي الموحّد، وهو منتدى يضمّ ممثّلين من كامل الطيف السياسي الفلسطيني، بهدف الاتفاق على أساس من أجل تقديم الضمانات للفصائل غير المنضوية تحت لواء منظّمة التحرير الفلسطينية بأنّ اتّخاذ القرارات سيتم من خلال شراكة حقيقية، من دون الطلب من هذه الفصائل تغيير مبادئها الحزبية الفردية.
ولهو من المفهوم طبعاً أنّ إصرار الخطّة على “المبادئ الرباعية” سيعقّد الأمور في هذا الخصوص. بيد أنّ هذا ينبغي أن يكون سبباً للتمنّع الفلسطيني وليس للتردّد. ووحده إطار سياسي شامل غير مشروط بقبول الفصائل من خارج منظّمة التحرير الفلسطينية بالمبادئ السياسية للمنظّمة قادرٌ في هذه المرحلة على تحقيق المصالحة الضرورية جداً بين الأفرقاء الفلسطينيين.
ومن غير الأكيد أبداً أنّ مبادرة كهذه يمكنها أن تنقذ القضية الفلسطينية. لكن لا ينبغي الاستهانة بقدرتها على تغيير الدينامية السلبية التي سيطرت منذ طرح الخطّة. لكن حتّى إن لم تؤدِّ إلى نتيجة، لا شكّ في أنّ ذلك أفضل من التكرار الجاف للكلام الذي ينعي حلّ الدولتين الذي أصبح بلا طائل الآن. لا بل أفضل من ذلك بكثير، بإمكان هذه المبادرة حثّ الفلسطينيين على اتّخاذ خطوات كان ينبغي القيام بها منذ زمن بعيد. ففي النهاية، كانت الإشارات الدالّة على ذلك واضحة منذ زمن. إذ يمكن النظر بموضوعية إلى الخطّة على أنّها مجرّد محاولة لجعل “الوقائع الراهنة”، كما قال المؤّلفون، وضعاً رسمياً، علماً أنّ النسخة المسيطرة من هذه الوقائع منذ زمن هي دولة ذات وضع أشبه بالدولة الفلسطينية في غزّة ودولة شبيهة أخرى في ما بقي من الضفّة الغربية.
وفي هذا المنطلق، لعلّ رؤية ترامب كانت ذات أهمّية من ناحية إيجابية واحدة مهمّة، ألا وهي أنّها سلّطت الضوء بشكل كبير على حقيقة مزعجة ينبغي على القيادة الفلسطينية مواجهتها في خضمّ تعاملها مع مسألة الخطوات التي ينبغي اتّخاذها بعد طرح الخطّة. وهذه الحقيقة هي أنّ السلطة الفلسطينية باتت أداة لإيقاع الشعب الفلسطيني في شركٍ داخليّ وتجريدهم من القوّة. فبموجب تحمّل المسؤولية، كسلطة وطنية، لرفاه الفلسطينيين تحت الاحتلال، فضلاً عن أمور أخرى، منحت السلطةُ إسرائيلَ حجّة معاكسة مهمّة ضدّ الاتّهامات بالفصل العنصري، قبل ظهور خطّة إدارة ترامب بكثير. ولن يؤدّي رفض الخطّة فحسب إلى تغيير هذا الواقع. فحتّى لو لم تتحوّل السلطة الفلسطينية إلى “الدولة الناقصة” التي تتصوّرها رؤية ترامب، أو رؤية رابين منذ 25 سنة خلت، ستستمرّ بتلبية هذه الحاجة السياسية الإسرائيلية المهمّة مع عرقلة قناةٍ من الأثر الإيجابي المحتمل من خلال هذه العملية.
لذلك، وبالتوازي مع الجهد المبذول لوضع استراتيجية تتماشى مع الأفكار أعلاه، لا بل كجزء لا يتجزّأ من هذا الجهد، ينبغي على الفلسطينيين القبول بما إذا كانوا سيتمكّنون من التحلّي بالعزيمة اللازمة لتحويل السلطة الفلسطينية من أداة لإيقاعهم في شركٍ داخليّ وتجريدهم من القوّة كما باتت إلى أداة التمكين التي ينبغي أن تكونها. إن لم يكن هذا الأمر ممكناً، فمن واجبنا الغوص في المهمّة المزدوجة الأصعب القاضية بإعادة تأهيل برنامجنا الوطني وإعادة تشكيل مؤسساتنا.
وسيكون من المعيب أن يتمّ فهم هذا كصدى للدعوة المكرّرة غالباً والموجّهة للسلطة الفلسطينية للانحلال عبر “إعطاء المفاتيح لنتنياهو” بكل بساطة. وحتّى لو تمّ اتّباع ذلك، لا تضمن خطوة كهذه بأن يتحقّق هدفها الضمني القاضي بتحويل الصراع إلى كفاح للمساواة في الحقوق ضمن دولة واحدة. لا بل الأمر بعيد البعد كلّه عن ذلك، فقد كانت تَرِكة اتفاقية أوسلو الأكثر صموداً سلطةً فلسطينية برهنت قدرتها على التكاثر، عبر التجزّؤ إلى “دولتَين ناقصتَين” منذ 13 سنة تقريباً. لكنّ ما ينبغي أن يكون مقلقاً أكثر، من دون استراتيجية وقائية فعّالة، هو ما أصبح قدرة ضمنية للسلطة الفلسطينية لأن تخلفها سلطةٌ هي تقمُّص لنفسها السابقة.




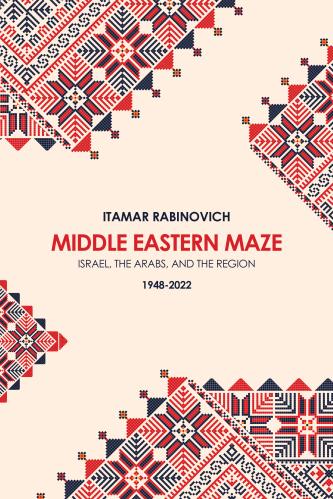
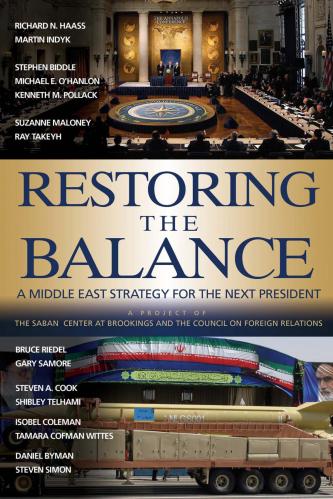
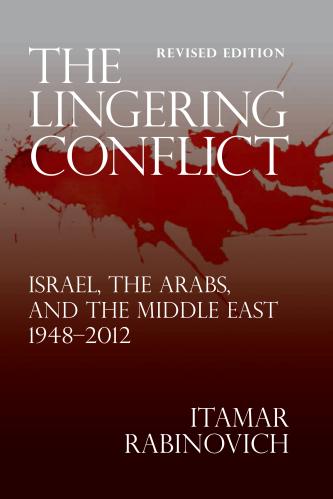

Commentary
خطّة ترامب للسلام في الشرق الأوسط: ما الذي يدعو فيها للاستياء؟
الجمعة، 21 فبراير 2020